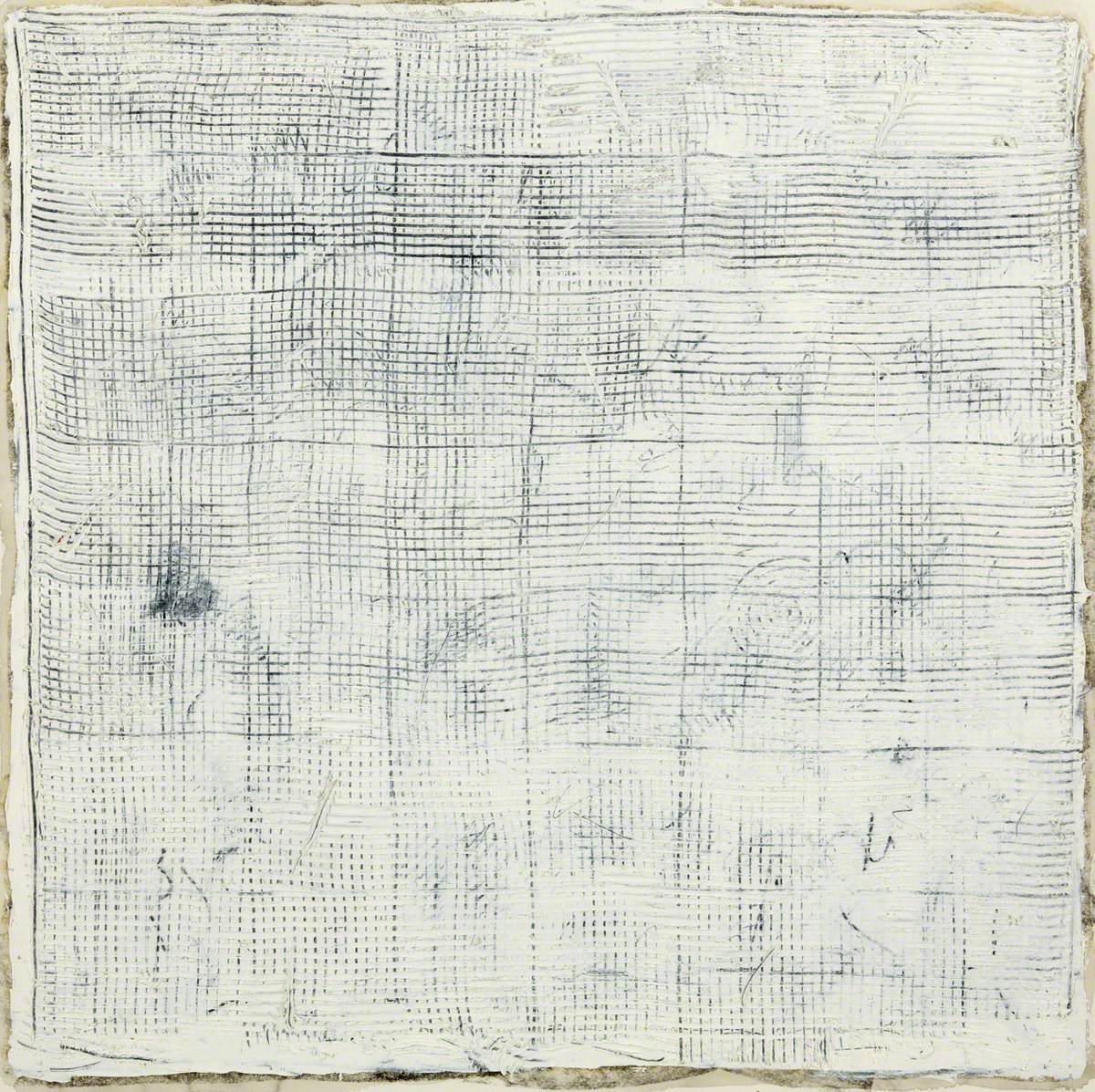هدف هذه الورقة هو إيضاح عددٍ من الأسئلة والمشاكل المستجدة في دراسة التشكيلات الاجتماعية المبنية عرقيًّا، والإشارة إلى بعض المبادرات الجديدة والمهمة الناشئة في بعض الحقول. ولهذا الغرض علينا مَوْضعة القطيعات التي تمثلها هذه الدراسات في حقل الدراسة القائم، وذلك بدوره يستلزم تشخيصًا عامًّا للحقل. سأبدأ بالخطوط العريضة، على مستوى عامٍّ جدًّا من التجريد، مع اعتذاراتٍ عابرةٍ عن التبسيط الضروري الداخل في ذلك. إن محاولات معالجة مسألة «العرق» مباشرةً أو تحليل التشكيلات الاجتماعية حيث العرق سمةٌ بارزةٌ، تشكّل – الآن – أدبيّاتٍ مَتينةً وهائلةً ومتنوعةً يستحيل تلخيصها تلخيصًا وافيًا، ولا يمكن إنصاف هذا التعقيد والإنجاز في حدود هذا النص.
ولكنْ من الممكن إدراك أمورٍ مهمّة حول ميدان البحث هذا بتقسيم العديد من المذاهب المتنوعة فيه بين مذهبين سائدين واسعين، كلٌّ منهما ولَّدَ دراساتٍ ومنهجيّاتٍ متنوعة تنوّعًا كبيرًا. ولكن انتقاء هاذين المذهبين ليس اعتباطيًّا تمامًا، فقد صار شائعًا اليوم إدراكهما كمذهبين متضادين بطرقٍ عدة. وكما هي الحال مع أي تضادٍّ نظريٍّ، يمكن إدراك الواحدِ منهما – بأوجهٍ عدّة – كصورةٍ معكوسةٍ عن الآخر. فكلُّ واحدٍ منهما يحاول التعويض عن ضعف النموذج المضاد وتشديد ما يسمى «العامل المُهمَل» فيه. وبمحاولته هذه يشير الواحد منهما إلى نقاط ضعفِ مفاهيمِ الآخر، ويشير لِزامًا إلى نقاط انطلاقٍ مهمة نحو تنظيراتٍ أوفى. ولكنّ كلًّا منهما، في رأيي، بموجب الشروط التشغيلية لتنظيرهِ الحالي، ليس وافيًا. فهذا الانقطاع بالتالي يشكل قطيعةً نظرية – جزئيّة كانت أو كلّية – مع كلٍّ من هاذين المذهبين السائدين، وقد تمكّن إعادةُ بناءٍ محتملةٍ للميدان النظري، بحد ذاته، من الابتداءِ بعملٍ مهمٍّ من نوعٍ جديد.
لأجل التبسيط، فلنقل إنّ المذهبين يمكن تسميتهما بالمذهب «الاقتصادي» والمذهب «السوسيولوجي». فلنبدأ بالأول: الاقتصادي. لتيسير الأمور فلنجمع طيفًا واسعًا من الدراسات تحت هذا العنوان العريض. وبين هذه الدراسات اختلافاتٌ في التأكيد واختلافاتٌ في الوضع المفاهيمي. ولهذا فبعض الدراسات وسط هذا المذهب تركّز على البنى الاقتصادية الباطنية، داخل تشكيلات اجتماعية محددة (وتحاليل البنى الاقتصادية والعرقية لجنوب أفريقيا مثالٌ جيد على ذلك). وغيرها ذات تركيزٍ منصبٍّ على العلاقات بين السمات الاقتصادية الباطنية والخارجية، مهما كان تشخيصها (نامية/متخلفة، إمبريالية/مستعمَرة، ميتروبوليتانية/تابعة، إلخ). أو تتضمن طرقًا مختلفةً جدًا لتصوير «الاقتصادي» مفاهيميًّا، استنادًا إلى افتراضاتٍ أو أطرٍ اقتصادية مختلفة جذريًّا. ولأغراض هذه الورقة، سأجمع داخل هذا المذهب – مؤجِّلًا بذلك معالجة الاختلافات المهمة – تلك الدراسات المؤطَّرة بإطار الاقتصاديات النيوكلاسيكية «التنموية» (مثل: التحليل ذو القطاعين: قطاع رأسمالي وآخر كفافي)، وتلك التي تتبنى نموذج التحديث أو التصنيع (مثل: الاستناد إلى شيء مثل نظرية والت روستو لـ «مراحل النمو»)، والأخرى، كدراسات منظّري «التبعية» المرتبطين بالمفوضية الاقتصادية لأمريكا اللاتينية، التي توظف نظرية جذرية لاقتصاديات التخلف العالمي، وغيرها، مثل بول باران أو أندري غندر فرانك، من يوظّفون توجّهًا ماركسيًّا (ومقدار ماركسيّته، كما سيتبين، كانت وما تزال محل جدل واسع). ما يتيح تشخيص هذه المنهجيات شديدة الاختلاف والقول بانتمائها إلى مذهبٍ واحدٍ هو ببساطة التالي: إنها تنطلق من اعتبار أنّ العلاقات والبنى الاقتصادية يعود لها الأثر المحدِّدُ الغالبُ على البنى الاجتماعية لهذه التشكيلات. وعلى وجه التحديد، تلك التقسيمات الاجتماعية التي تتخذ سمةً عرقيّةً أو إثنيّة بارزة يمكن تعزيتها أو تفسيرها أساسيًّا بالإحالة إلى البنى والسيرورات الاقتصادية.
المنهج الثاني هو ما أسميته السوسيولوجي. وهنا مرةً أخرى – وبنحوٍ مُغرِض – جمعتُ تشكيلةً متنوعة من المناهج تحت عنوانٍ واحد. بعضها يركز على العلاقات الاجتماعية بين الشرائح الهرمية العرقية أو الإثنية المختلفة. وبعضها يعالج الاختلافات الثقافية (الإثنية) حصرًا، حيث العرقيّة منها ليست إلّا مثالًا واحدًا متطرّفًا. والبعض يستهدف نظريّةً رصينةَ التنوّع، اشتقاقًا من ج. س. فرنيفال وم. ج. سميث وغيرهما من تلك المدرسة. وآخرون انشغلوا حصرًا بأشكال السيطرة أو الغبن السياسيين، استنادًا إلى استغلال التمايز العرقي. وفي الأغلبية الساحقة من هذه المباحث، يُعَالَج العرق بصفته تصنيفًا اجتماعيًّا. فالتصويرات البيولوجية للعرق اضمحلّت أهميّتها اضمحلالًا كبيرًا، رغم أنّ اختفاءها بعيد المنال (مثلًا: إحياء السوسيولوجيا-البيولوجية، واستحضار النظريات المستندة إلى البيولوجيا، عبر المبدأ الجيني، في الأعمال الأخيرة لجينسين وإيسينك). ينصب التشديد الرئيس في المذهب الثاني على العرق أو الإثنية بصفتهما سماتٍ اجتماعيةٍ أو ثقافية للتشكيلات الاجتماعية محلّ النقاش. ومرةً أخرى ما يميّز المساهمين في هذه المدرسة بالانتماء – لأغراضنا فقط – إلى مذهبٍ واحدٍ هو التالي: مهما كانت اختلافاتهم الداخلية، فالمساهمون في المذهب السوسيولوجي يتفقون على استقلالية العرق والإثنية كسماتٍ اجتماعية وعلى تعذُّر اختزالهما. فهما – حسب آرائهم – يُظهِران أشكالهما الخاصة للبناء، ولهما آثارهما الخاصة، ولا يصح تفسيرهما تفسيرًا مراوِغًا كمحض أشكال سطحية لمظهر العلاقات الاقتصادية، ولا يمكن التنظير حولهما تنظيرًا وافيًّا باختزالهما في المستوى الاقتصادي للتحديد.
هنا يمكن رؤية الكيفية التي وفقها يتعارض النموذجان الفكريان، ليصحّح كلٌّ منهما ضعف ضدّه. فالمذهب الأول – سواءً كان ماركسيًّا أم لا – يمنح سمةَ التحديد العامة للمستوى الاقتصادي. فهذا، كما يقال، يقدم مركزًا صلبًا (أساسًا ماديًّا) عوضًا عن المركزية الناعمة للدراسات الإثنية وثقافويّتها. وتشديد الأوجه السوسيولوجية، في المذهب الثاني، هو إذن ردٌّ مباشرٌ نوعًا ما على ذاك التأكيد الأول، ويستهدف إدخالَ تعقيدٍ ضروريٍّ في المخطوطات التبسيطية للتفسير الاقتصادي، وتصحيح ميله نحو الاختزالية الاقتصادية. فالتشكيلات الاجتماعية – حسب المذهب الثاني – هي تجمّعاتٌ معقَّدةٌ، مكوّنةٌ من بنى متعددة مختلفة، ليس منها ما يقبل الاختزال في الآخر. ولهذا، بينما شكل الأول ينزع نحو الأحادية السببية، فتركيز الثاني ينزع نحو التعددية، حتى وإن لم يكن صريحَ التعددية بالمعنى النظري.
وسنرى لاحقًا أنّ هذه المناظرة تعيد إنتاج المناظرات الاستراتيجية الأكبر (بشكلٍ مُصغّر) التي شغلت ميدان العلوم الاجتماعية في السنوات الأخيرة. وعليه فمن اللازم أن يكون للتطورات في هذا الميدان الأكبر – سواءً كان موضوع بحثها المعين هو التشكيلات الاجتماعية المبنية عرقيًّا أم لا – آثارٌ نظرية في منطقة الدراسة تلك. وعليه ترتبت عواقب مثل انقطاعاتٍ في النموذج الفكري نحو «النظريات السوسيولوجية للعرق». ولكنّ المناظرة ليست نظريّةً حصرًا. فلِاختلافات التحليل والمنهج النظريين آثارٌ حقيقيةٌ على استراتيجيات التغيير السياسي لمثل هذه المجتمعات. فإن كان المذهب الأول صحيحًا عمومًا، فما يُعاش ويحلل كصراعاتٍ إثنية أو عرقية هو حقيقةً تمظهراتُ تناقضاتٍ اقتصاديةٍ أعمق. وعليه فجوهر سياسات التغيير يجب أن يتصدى لتلك الأخيرة. والمذهب الثاني يجذب الانتباه للأشكال الفعلية للصراع السياسي والتوتر الاجتماعي في مثل هذه المجتمعات ولديناميّاتها – التي يكثر ما تتخذ سمةً عرقيةً أو إثنيةً. ويشير إلى الصعوبة الإمبريقية في استيعاب هذه مباشرةً في الصراعات الاقتصادية الأكثر كلاسيكيّةً. ولكن إن كانت العلاقات الإثنية تتعذر الرد إلى العلاقات الاقتصادية، فهذا لا يعني أن الأولى لن تتغير أبدًا مع تغير الثانية. وعليه، ففي الصراع السياسي، يجب أن تعطى الأولى تحديدها ووزنها الذي تستحق كعوامل مستقلة. وللنظرية هنا – مثلما في كل موقع آخر – عواقب عملية مباشرة أو مُدَاوِرة.
تقدم الظروف السياسية أحد شروط وجود النظرية أيضًا، وتحمل آثارًا على تطبيقها وتمييزها – وإن لم تكفي لتحديد قيمتها العلمية. وقد انطبق ذلك بوضوحٍ على أمريكا اللاتينية والكاريبي، وإن فقط عليهما (مثلما سيكونان محل تركيزنا في جزءٍ معتبر من هذه الورقة). ونموذج القطاعيْن – المستند إلى التنمية الاقتصادية الهادفة للتصدير، واستبدال الواردات، ودعم الاستثمار الأجنبي – رعى حقبةً طويلةً وكارثيةً من التنمية الاقتصادية الوطنية، ساهمت في تقويض الوضع الاقتصادي للبلدان واحدةً تلو الأخرى في المنطقة. فنظرية التحديث احتلّت لمدة طويلة الصدارة الاقتصادية لاستراتيجيات «التحالف لأجل التقدم» في القارة. سُخِّرت نسخ مدرسة «التبعية»، تحت شروط مختلفة، للترويج لتنميةٍ جذرية النوع، رأسمالية-وطنية، ومناهضة للإمبريالية. وأما نظريات المتروبول/التابع – التي وضعها غندر وفرانك وغيرهما – طُوِّرت تحديدًا في سياق الثورة الكوبية والاستراتيجيات التي أفصحتها ثورة أمريكا اللاتينية، مثلًا في قرارات الإعلان الثاني لهفانا لعام 1962. بل والميدان بأكمله يوفر حالةً بديعةً للدراسة حول الترابط الضروري بين النظرية والسياسة والأيديولوجية في العلم الاجتماعي.
كل مذهبٍ يكشف شيئًا ما من مركزه العقلي، وبالتالي قد لا يكون من الممكن القيام بتفسير مراوغٍ للعرق بالإحالة إلى العلاقات الاقتصادية حصرًا. ولكن المذهب الأول محقٌّ بلا شك في إصراره على أن البنى العرقية لا يمكن أن تُفهم فهمًا وافيًا خارج إطار مجموعة محددة تحديدًا شديدًا من العلاقات الاقتصادية. فإنْ أريد تفادي إضفاء سمة الواحد الأحد العابر للتاريخ على العرق – بحيث أينما ومتى ما يظهر، يتخذ دائمًا السمات المستقلة نفسها، ويقبل التفسير بنظريةٍ عامةٍ ما للانحياز في الطبيعة الإنسانية (حجّةٌ جوهرانية كلاسيكية النوع) – على المرء التعامل مع الميزة (specificity) التاريخية للعرق في العالم الحديث. وهنا من اللازم على المرء تأييد فكرة أن العلاقات العرقية مرتبطةٌ ارتباطًا مباشرًا بالسيرورات الاقتصادية: تاريخيًّا في حقب الغزو والاستعمار والسيطرة المركنتالية، واليوم في «التبادل غير المتكافئ» الذي تتسم به العلاقات الاقتصادية بين المناطق الاقتصادية للاقتصاد العالمي، المتقدمة النمو الميترو-سياسية في كفة، والتابعة «المتخلفة» في كفة أخرى. والمشكلة هنا ليست معنية بما إذا كانت البنى الاقتصادية مرتبطة بالتقسيمات العرقية، بل حول كيفية الترابط النظري بين الاثنين. فهل للمستوى الاقتصادي أنْ يوفر مستوى وافيًا ولائقًا لشرح السمة العرقية لهذه التشكيلات الاجتماعية؟ ها هنا يُدْخِل المذهب الثاني تحفّظه. فبالمثل، لا بد أن المذهب الثاني محقٌّ في جذبه الاهتمام لتميز تلك التشكيلات الاقتصادية التي تُظهِر سماتٍ عرقية أو إثنية بارزة. ونقدُ الاختزالية الاقتصادية محقٌّ بالتأكيد. فالمشكلة هنا هي تفسير ظهور هذه «الأشياء الأخرى» – هذه العوامل اللا-اقتصادية ومكانتها في دينامية إعادة إنتاج مثل هذه التشكيلات الاجتماعية. ولكن هذه «المشاكل الحقيقية» تُعيننا أيضًا على تحديد نقاط الضعف تلك التي تعتم عليها الانقلابات التي يمارسها كل نموذجٍ فكريٍّ على الآخر. فإن كانت النزعة السائدة في النموذج الأول هي محاولة إدارة كافة الاختلافات والميزات داخل إطار منطقٍ اقتصاديٍّ مُبسِّطٍ، فتلك السائدة في الثاني هي الاكتفاء بصفيف من التفسيرات التعددية، المفتقرة إلى التنظير الوافي، والمنتهية إلى عرضٍ توصيفيٍّ لا تحليليٍّ. وهنا بالطبع نحن نعبّر عن الاختلافات بشكلها الأكثر حدّيةً والأشد تبسيطًا. ومن القيّم هنا أن نستكشف بعض الأراضي والحجج المعقدة التي تحتويها هذه الثنائية.
يمكن تحديد الوجه الأول بالنظر إلى بعض سمات الجدالات المؤخرة التي نشأت حول تحليل التشكيلة الاجتماعية الجنوب أفريقية. فمن الواضح أن جنوب أفريقيا «حالة حدّية» (limit case) بالمعنى النظري، وهي «حالة اختبارية» بالمعنى السياسي. ولعلها هي بالذات التشكيلة الاجتماعية حيث لا يمكن إنكار بروز السمات العرقية ولو للحظة. ومن الجلي أنّ البنى العرقية للمجتمع الجنوب أفريقي لا يمكن تعزيتها إلى الفروقات الثقافية والاقتصادية وحدها: إنها خائضةٌ وغارقةٌ في أشكال السيطرة السياسية والاقتصادية التي تهيئ بنيةَ التشكيلة الاجتماعية ككل. ولكن بعض الخلاف مقبولٌ حول ما إذا كان النمط الرأسمالي للإنتاج هو النمط الاقتصادي السائد في هذا التشكيلة الاجتماعية. فالحق يقال، جنوب أفريقيا هي الحالة «الاستثنائية» (؟) حيث نجد تشكيلةً اجتماعيةً رأسماليةً صناعيةً العرقُ فيها مبدأٌ مُمَفْصِلٌ للبنى الاجتماعية والسياسية والأيديولوجية ومفصحٌ عنها، وحيث النمط الرأسمالي يُستدام عبر النهل – المتزامن – مما عُرِّفَ كعملٍ «حر» و«قسري» في الآن نفسه.
حسنًا، إنّ أجزاء معتبرة من الأدبيات حول التشكيلة الاجتماعية الجنوب أفريقية تتعامل مع الوجه العرقي للمجتمع كأمر تفسرهُ – جوهريًّا – العلاقات الاقتصادية الحاكمة. وهذه العلاقات تُصَنَّف – لجميع الأغراض العملية – كعلاقاتٍ طبقية بالمعنى الكلاسيكي. وبناءُ القوة العامِلة الجنوب أفريقية بين طبقتيْن سوداء وبيضاء يُحَلَّل بالتالي كمثيلٍ لـ «تصديع» الطبقة العاملة؛ أمرٌ يمكن للمرء أن يجده في كافة التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية – إنما بِسِيمة واحدة هنا وهي أنّ العرق هو الآلية التي ينجز بها هذه التراتب الطبقي. فكما لاحظ هارولد وولب، هذه التحليلات تفترض أنّ الطبقتين العاملتين البيضاء والسوداء لهما علاقةٌ متماثلة جوهريًّا مع رأس المال. وعليه تقع دينامية العلاقات الاجتماعية في المنطق الأساسي للنضال الطبقي الذي تتخذه العلاقات أو الإنتاج الرأسماليّان كلاسيكيًّا. والتقسيمات العرقية هنا «ليست إلّا شكلًا محددًا يتخذه تصديع الطبقة العاملة – الشائع في كافة الأنماط الرأسمالية للإنتاج – في التشكيلات الاجتماعية الجنوب أفريقية».[1] مثل هذه التحليلات – وولب يستشهد بِعدّة مراجع – تميل إذن إلى الوقوع فيما عرّفناه كنموذجنا الفكري «الأول»: إدراج البنى العرقية تحت «منطق» العلاقات الاقتصادية الرأسمالية. وهذا المنهج يمكن إقرانه بسهولة بنقيضهِ المباشر المقلوب. هذه التحليلات البديلة تعالج التشكيلات الطبقية الاقتصادية كأمور لا صلة لها عمومًا بتحليل البنى الاجتماعية والسياسية، حيث العرق – عوضًا عن الطبقة – يُعَامل كالعامل المهم، من خلاله يُبنَى المجتمع اجتماعيًّا وحولهُ تَتَولّد الصراعات الاجتماعية. يمكننا رؤية مثل هذا التحليل، مثلًا، في كوبر[2] وفان دين بيرغي.[3]
والأهم من ذلك بكثير – والأصعب تحديدًا في أي من المنهجين – هو عمل جون ريكس، وهو الآخر جنوب أفريقي وعالم اجتماعٍ متميز. لم يعمل ريكس بكثافة على المواد الجنوب أفريقية، ولكن كتابته – رغم ما يلازمها بالضرورة من منهجه الخاص – تمثل المنهجية «السوسيولوجية» في أثرى نقاطها وأعقدها. ومقال ريكس الأول حول الموضوع، المعنون «المجتمع الجنوب أفريقي في منظورٍ مقارن»[4] يُفتتح بنقدٍ لإخفاق كلٍّ من المنظوريْن البنيوي-الوظيفي والماركسي في التعامل مع العرق والإثنية في مجتمع جنوب أفريقيا تعاملًا ناجعًا. ويوجّه نقدًا مكافئًا لنظرية «التعددية» لفورنيفال وسميث – وإن كان يعيرها انتباهًا أكبر. فقد جادل سميث أنّ الأجزاء الإثنية المختلفة للمجتمع الكاريبي كانت متمايزة «تعدّديًّا»، لا يجمعها إلا الاحتكار؛ احتكارُ جزءٍ واحدٍ منها، للقوة السياسية: «احتكار القوة من قطاعٍ ثقافيٍّ واحدٍ هو الشرط المسبق الجوهري للحفاظ على المجتمع الكلي بشكله الحالي».[5] وضدّ هذا القول يجادل ريكس محقًّا أنّ «ديناميّات المجتمع تدور حول انخراط رجالٍ من خلفياتٍ إثنية مختلفة في الأوضاع الاجتماعية نفسها، أي: المزرعة الاستعبادية».[6] ويمكن قول الشيء نفسه بصدد محاولات تمديد نموذج «المجتمع التعددي»، بتشديده الاهتمام على التجزئة الثقافية ونَسبِه عامل الاتساق إلى حالة الاحتكار السياسي، ليشمل جنوب أفريقيا. ولكن ريكس يوجه نقدًا مكافئًا لأي محاولةٍ لتفسير الأشكال العرقية التي يظهر بها الصراع الاجتماعي في مثل هذه المجتمعات كنوعٍ من أنواع «الوعي الزائف».
يسند ريكس منهجه الخاص إلى الحقيقة التاريخية المهمة للاختلاف. وحيث الرأسمالية – كلاسيكيًّا – أُسست عبر توسعة علاقات السوق، بإنتاجٍ يستند إلى «العمالة الحرة»، فالرأسمالية في جنوب أفريقيا نشأت على أساس الغزو (غزو شعوب البانتو) وإلحاقهم في علاقاتٍ اقتصادية على أساس «العمل غير الحر»، «كجزءٍ من نظامٍ رأسماليٍّ للإنتاج فعّال». وهذا الأمر يدشّن النمط الرأسمالي على «منطلقات» تاريخية مختلفة جدًّا عن تلك المشتقة من التفسير العام الذي يقال إنّ ماركس قدّمه – وإن كانت هذه المنطلقات تتميز بها التشكيلات «الاستعمارية» أكثر من غيرها، حيث الغزو والاستعمار كانا سيمةً مركزية، وبالتالي هي معنيّةٌ في هذه المجتمعات لا بظهور «الصراع الطبقي الذي تولده التنمية الرأسمالية، بل «الحرب العرقية» التي يولدها الغزو الاستعماري».[7] وريكس يولّي أهمّيةً كبيرةً لهاتين السمتين المفرِّقتين: «قدرةُ الموظِّفين على إدارة استخدام العنف الإكراهي في أثناء الغزو الاستعماري وبعده»، وحقيقةُ أنّ «المؤسسة العمّالية المركزية» ليست العمَالة الحرة الكلاسيكية بل «العمالة المهاجرة بشكلها غير الحر».
باتخاذ ريكس هذه «المؤسسة العمّالية المركزية» غير النمطية أبدًا كسمةٍ مركزيةٍ لتحليله، يتمكن من رسم حدودٍ أدقّ للآليات الاقتصادية المحددة التي عملت على «إلحاق» الطبقة العاملة الأفريقية في النظام الرأسمالي بطرقٍ تحافظ على سمته العرقية التجزيئية بدلَ تصفيتها. وبهذا تتخذ البنية العرقية للتشكيلة الاجتماعية الجنوب أفريقية شروطَ وجودٍ اقتصادية ملموسة – والرابط يمكن تقفّيه تحديدًا عبر «خصوصيته» (peculiarity) وشذوذه عن المسار الرأسمالي «الكلاسيكي». ويتقفى ريكس تاريخيًّا الأشكال الاقتصادية المتنوعة لهذه «اللا حرية»: الخزان الريفي، معسكر العمال، بروز العنصر الثالث لنظام العمالة المهاجرة، «الموقع المحلي الحضري». «كل العمالة الأفريقية تقريبًا لها حصةٌ بطريقةٍ ما في سمة عمالة المخيّمات والعاملة المنزلية. وكلها تحت طائلة تشريعات السادة والخدم، وليس فيها من هو كامل الحرية، رغم أن تطور قطاع الصناعة الثانوي قد يؤدي إلى تعاظم مرونة الأجور، وتعاظم ديمومة اليدِ العاملة ومن ثم تعاظم الاعتراف بحاجات العامل للقرابة والجماعة».[8] يرى ريكس أن هذه «الاختلافات»، في نمط دخول العمالة الأفريقية وفي حالتها على حدٍّ سواء، تشتغل أساسًا من خلال وسيلة إلحاق إمدادات العمالة الأفريقية بالصناعة الرأسمالية. فالعلاقات الاقتصادية إذن هي الشرط الضروري – وإن لم يكن الكافي – للبنية العرقية للتشكيلة الاجتماعية الجنوب أفريقية. وهذه الأخيرة تحفظها أيضًا عناصر «غير معيارية – مثل العوامل السياسية والقانونية – تنبع من السيطرة السياسية للطبقة الرأسمالية الاستيطانية البيضاء على الدولة، و«الحل الوسط العملي» بين هذه الطبقة والطبقة العاملة البيضاء، ما يؤدي إلى أن تقطف كلاهما ثمار تقييد عمالة الأصليين بِمكانة التابع في سوق العمل. وفي سياق الخط «الكلاسيكي» للتنمية الرأسمالية، فإنّ رأسماليةً كهذه، تحفظُ سماتٍ «لا عقلانية» كهذه بدلًا من أن تلغيها، لا بدّ أنها – في أقل الأحوال – حالة «شاذة» ».
وبالتأكيد لا تضادّ بسيط بين العاملين «الاجتماعي» و«الاقتصادي» هنا. فلا يحق لأحد اتهام ريكس بإهمال مستوى العلاقات الاقتصادية، كما يفعل الكثير من «الثقافويين». فالحق أنّ اهتمامه بتميزِ أشكال العلاقات الاقتصادية الخاصة بالحالة الجنوب أفريقية، هو ما يمكنه من إدراك بعض السمات الأساسية لتشكيلةٍ اجتماعية هي – على حدٍّ سواء – «رأسمالية» بنحوٍ واضح ومع ذلك مختلفة في بنيتها عن «النوع الرأسمالي» للتنمية الاجتماعية – في اشتقاق هذه الأخيرة من قراءةٍ محددة للأدبيات الماركسية. والاهتمام الموجه إلى «المؤسسات المركزية للعمالة» لهذه التشكيلة يمكّنه من إبراز ما أسماه ماركس في سياقٍ آخر بـ «الحد» (differentia specifica)، وهو كما يقول أساسُ التجريد الوافي الخاص تاريخيًّا: «هي الأشياء التي تحدد نموها، أي: العناصر التي ليست عامةً أو شائعة، يجب تفرقتها . . . حتى لا ينسى اختلافها الجوهري في وحدتها».[9]
ولا إهمال فيه للعلاقات الطبقية أو للصراع الطبقي. فهو يرفض المنهجية التجزيئية لـ «التعددية» رفضًا قاطعًا. «إن وجدت انقسامات، يمكن النظر لها كانقساماتٍ مُدْمجة وظيفيًّا داخل نسقٍ عامٍّ للصراع السياسي تولده التنمية الرأسمالية للبلد منذ اكتشافات المعادن في 1867 و1886». فـ «التحريف» (revision) المتضمن هنا يعنى تحديدًا برفض أي محاولة لإتباع هذه بأي شكلٍ كونيٍّ أو أحاديِّ المعنى – «العلاقات الطبقية الرأسمالية» بالعموم. «من الواضح أن ما لدينا هنا ليس شيئًا يمكن تفسيره تفسيرًا لائقًا بالاحتكام إلى قانونٍ ماركسيٍّ كونيٍّ ما للصراع الطبقي، بل إلى نوعٍ خاصٍّ من الصراع الطبقي بلا شك، وهو بالتحديد نوعٌ حيث الطبقاتُ عبارةٌ عن مجموعاتٍ ذات حقوقٍ ولا-حقوقٍ متنوعة ومتدرجة، استنادًا إلى نوع الغزو واللا-حرية الذي فرض عليها في حقبةٍ سابقة. والتاريخ، بنيةُ وأشكالُ التفرقة الاجتماعية التي تقدمها الطبقة الفلّاحية [أي: وجهها «العرقي»]، مثلما في أي مجتمعٍ استعماريٍّ سابق، هو نتاج هذا الغزو وهذه اللا-حرية». هاذان المعياران – الغزو والعمالة «اللا-حرة» – هما الآليات المفاهيمية النقدية التي عبْرها يُنظَّم تحليل ريكس. و«أصل» النمط الرأسمالي في شروط الغزو، بترابطٍ مع «المؤسسات المتميزة» للعمالة اللا-حرة، إذن، يحفظ – على المستوى الاقتصادي – سمات الانتماء العرقيّ المستمرة الخاصة به ويؤمّنها. هذه رأسماليةٌ من نوعٍ مخصصٍ جدًّا ومحدّدٍ جدًّا: «العلاقات بوسائل الإنتاج اختلافها متعدّدٌ بنحوٍ طفيف لا تدركه مصطلحات التمييز بين المُلّاك وغير المُلّاك»، وكلٌّ منها «يَنتج عنه وضعيات طبقية خاصة . . . طيفٌ كامل من الوضعيات الطبقية». فالتحليل إذن يبدأ بالمستوى الاقتصادي ولكن يختلف عن نوعه الكلاسيكي.
إنما يضاف إلى ذلك علاقاتٌ أخرى لا تقبل النسب إلى «العلاقات الاجتماعية للإنتاج»، ومنها التمايزات على مستوى الثقافة والقيم – تحافظ عليها مثلًا بنىً مؤسسيةٌ كنظام البانتو للتعليم وأشكاله للقوة السياسية – المؤسسة عبر فصل القوة السياسية والقوة الاقتصادية، مثل تحكّم البِيْض بالقوة السياسية. وهذه تولد صراعاتٍ بين مجموعاتٍ متمايزة عن صراعات «التحكم بوسائل الإنتاج». وهنا التحليل يشتمل على وضعية المجموعات الاجتماعية – مثل «الطبقة الوسطى» الأفريقية، وملوّنو الكيب، والتجّار الهنود – التي لا يمكن إدماجها بسهولة في التحليلات المبكرة للعلاقات الاقتصادية. ومنها تنشأ العديد من السمات الانتمائية للبُنية «المغلقة» للعلاقات الاجتماعية لجنوب أفريقيا.
ومع أنّ هذا التحليل متركزٌ على «ميزة النظام الجنوب أفريقي» فهو لا يقتصر عليه. فقد اقترح ريكس مخطوطةً مماثلة كقاعدة لتحليل العلاقات الإثنية في أمريكا اللاتينية والكاريبي،[10] وفيه أيضًا يبدأ بترسيم حدود «الأشكال الأساسية للاستغلال الاقتصادي الناشئة من الشروط الاستعمارية»، منها «الأنواع الأخرى المحتملة للاستغلال والمراكمة الرأسمالية وغير الرأسمالية». فعلى سبيل المثال يشتمل هذا المدى على أشكالِ العمالة «غير الحرة» و«شبه الحرة» – اقتصاد العبودية ونظام المزارع، وتشكيلةُ «الفلّاح التابع». ويتضمن ذلك طيفًا مماثلًا من الشرائح الطبقية الاجتماعية – فهناك «المستوطِن»، والجماعات التجارية المنبوذة، والوسطاء، والزعامات (caciques)، والمبشّرون، والإداريون. والشكل العام لمقولته هذه قريبٌ جدًّا من الذي وظفه في الحالة الجنوب أفريقية. «بعض هذه المجموعات متعارضة كطبقاتٍ بالمعنى الماركسي. ولكنها جميعًا تشكّل مجموعاتٍ متقاربة نسبيًّا بخصالها الثقافية وتنظيماتها الاجتماعية المتمايزة. والأثر العام هو تخالطٌ وتوالجٌ أكبرُ مِنْ أن يُبرَّرَ وصفه بنظامٍ للطوائف الطبقية (caste system)، وفيه إغلاقٌ لطرق الحركة أشد من أنْ يسمح بتسميته بنظام تراتبٍ طبقيٍّ اجتماعي (social stratification). وهو أشد تعقيدًا، لما يحتويه من تخالط أنماط الإنتاج، من أن يوصف كحالة صراعٍ طبقيٍّ بالمعنى الماركسي. كل هذه الأوجه يجب وضعها بعين الاعتبار عند الحديث عن نظامٍ استعماريٍّ للتراتب الطبقي الاجتماعي».[11]
على المستوى النظري الأوسع، علينا رؤية ذلك كنموذجٍ مُؤَسَّسٍ على تصحيحٍ نظريٍّ محدّدٍ جدًّا. وإن أوضحناه، مع تبسيطٍ ضروريٍّ وإنْ لم يكن مبالغًا، سنقول إنّه يدمج عناصر منهجين ماركسيٍّ وفيبري. ولكن هذه التوليفة تُؤمَّن، جوهريًّا، على أرضٍ فيبرية. ولست أقول ذلك لأن ريكس يداوم على تبيان تضادّ منهجه مع ما يرى أنه تطبيقٌ تبسيطيٌّ وغير لائق لـ «القانون الماركسي للصراع الطبقي» – رغم أنه يداوم على ذلك. بل هذا التشخيص يشير إلى البنية المفاهيمية لتصحيحات (revisions) ريكس. فهذه التوليفة تُنْجَز نظريًّا بِطريقتين مختلفتين تكامليّتين. الأولى هي إبعاد التحليل عما يُصوَّر مفاهيميًّا كمنهجٍ ماركسيٍّ «كلاسيكي». وجزءٌ كبيرٌ منه يعتمد على كيفية وضع هذا التعريف. تُوصَف الماركسية «الكلاسيكية» كنمطٍ للشرح يفترض أنّ كافة اللحظات السابقة للصراع تقبل الإدراج تحت الصراع الطبقي وهو يسود عليها. والطبقات تُعرَّف بالموقع الاقتصادي – وتعريفها الفضفاض هو بين «مُلّاك ولا-مُلّاك» وسائل الإنتاج. كلٌّ من المجموعتين طبقةٌ اقتصاديةٌ «بحدّ ذاتها» يمكن تنظيمها، من خلال السعي وراء مصالحها الاقتصادية المتمايزة في الوضعيات التنافسية للسوق، وبالصراع الطبقي، لتصبح «طبقةً لأجل ذاتها». يُعرَّف المنهج الماركسي هنا أيضًا بمجموعة من الافتراضات المعنية بشكل التنمية الرأسمالية ومسارها ومنطقها. والشكل الكلاسيكي هو الشكل حيث تواجِهُ العمالةُ الحرة الرأسماليينَ في سوق العمل. ليس للرأسمالية «أن تنبع إلى الحياة إلّا مع تصادف مالك وسائل الإنتاج والكفاف في السوق مع العامل الحر الذي يبيع قوّة عمله. وهذا الشرط التاريخي لوحده يشكل تاريخَ عالَم».[12] فالمسار التاريخي إذن هو الذي يجعل هذا الصراعَ بين المُلّاكِ وغير المُلّاكِ، مجموعةَ العلاقات المعيارية والسائدة والمحدَّدة في كل التشكيلات الاجتماعية حيث النمط الرأسمالي هو السائد. والمنطق الكلاسيكي يقول إنّ «العقلانية الاقتصادية» لعلاقات السوق الرأسمالية ستطغى عاجلًا أم آجلًا على تلك العلاقات النابعة من أنماطِ إنتاجٍ سابقةٍ باتَتِ اليومَ مُزاحَة، وستحولها، حتى «تشبكَ» العلاقاتُ الرأسمالية العلاقاتِ السابقة لها بِتأرجحها. يبعد ريكس نفسه عن هذا الشرح «الكلاسيكي»، على أساس الاختلافات المعتبرة بينه وبين التشكيلات الاجتماعية الفعلية المفترض منه شرحها. وإن كان يقرّ بأنه حيثما كانت الرأسمالية تكونُ الصراعات الاقتصادية رأسمالية النوع (الصراعات الطبقية)، فالتشكيلات الاجتماعية استعمارية النوع تُظهِر أشكالًا مختلفةً تتخذ مساراتٍ أخرى وتخضع لمنطقٍ مختلف. ويضاف على ذلك احتواء مثل هذه التشكيلات الاجتماعية على علاقاتٍ بنيوية أخرى لا يمكن تعزيتها للعلاقات الطبقية من نوعٍ رأسماليٍّ كلاسيكي.
السمة الثانية هي إنعاشٌ لتلك المشاكل في إطارٍ فيبري «كلاسيكي». ونعني بذلك أنّه إطارٌ معاكسٌ لِمن تبنّوا فيبر ضدّ ماركس في سبيل الابتعاد القاطع عن السمات الاقتصادية-البنيوية، نحو سماتٍ خاصةٍ بـ «البنية العلوية»، إذ يعمل ريكس دائمًا انطلاقًا من وجهٍ يَكثر إغفاله من عمل فيبر، يتعامل بكثافةٍ مع العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك – بالطبع – الصراع الطبقي الاقتصادي رأسماليُّ النوع، من ضمن مدى للأنواع الممكنة لمثل هذه العلاقات. وهذا تشديدٌ فريدٌ يتيح لريكس اشتمال التحليل الماركسي للعلاقات الطبقية بصفتها لونًا واحدًا محدودًا من ضمن طيفٍ أوسع شمولًا للعلاقات الاقتصادية، تُعرَّف كـ «نماذج مثالية». ومنهجيةُ «واحدٍ من طيفٍ» هذه تتيح شرح علاقاتٍ اقتصادية أخرى أيضًا، لتفسير سماتٍ خاصةٍ بِتشكيلاتٍ اجتماعية لا تَظْهُر عليها البنية الرأسمالية الكلاسيكية المؤقنمة الخاصة بماركس. فبالنسبة لفيبر، تُصوَّر الصراعات الطبقية الاقتصادية مفاهيميًّا ليس إلا كواحدة من طيفٍ من الوضعيات الممكنة للسوق، في علاقاتٍ حيث المجموعات – بتكويناتها المختلفة – تتصارع في تنافس. وبالنسبة لفيبر، لا تتداخل هذه العلاقات الاقتصادية المختلفة لتشكّل شيئًا يمكن تسميتهُ: الشكل العام للصراع الطبقي. فالمجموعات المتنافسة في صراعٍ حول الحظوة والمنزلة قد لا تكون ذات المجموعات المتنافسة على السيطرة على موارد شحيحة. ولذلك يقوم ريكس في عمله حول الهجرة والإسكان بالتمييز بين المجموعات الاقتصادية وداخلها، وفق التراتب الطبقي لسوق الإسكان – وإزّاءه يُعرِّف مجموعةً من «الطبقات الإسكانية» المتمايزة. ويتبع من ذلك أنّ المجموعات السائدة في كل وضعيةِ سوق لا تتسق لتشكل شيئًا واحدًا بنحو يصح تسميته بالطبقة الحاكمة بالمعنى الماركسي. فعلى المرء بدلًا من ذلك الانطلاقُ من كلّ حالةٍ إمبريقية ليولّد طيفًا من وضعيات السوق المثالية النموذجية، هي مجموع هذه البنى المتعددة المكوِّنة للتشكيلة الاجتماعية. وهذا لا يعني أنّ التحليل يستثني مسائل الاستغلال. ولكن هذه ليست طابعًا عامًّا، بل تظلُّ طابعًا يستلزم التحديد في كل حالة فردية. وعليه نجد أنّ فيبر في شكله «الأصلب» هذا – إن صح التعبير، فيبر بـ «تصحيحٍ» ماركسي – هو القاعدة النظرية للتوليفة التي يطرحها ريكس. فالحل إذن لمعالجة شكلٍ محدودٍ أُحاديّ الجانب للتحليل الماركسي هو تبنّي «فيبريّة يسارية» قوّية ومميزة. يجب الإشارة هنا إلى أنّ هذا «الحل» لا يقتصر حصرًا على من عارضوا «الكليّة» (totalism) لأشكال التحليل الماركسي. فقد أشير مؤخرًا[13] إلى أنّ بعض المنظِّرين الماركسيين حينما لزم عليهم إدماج بنىً سياسية وأيديولوجية في تحليلٍ اقتصاديٍّ ماركسيِّ النوع، حاولوا هم أيضًا في بعض الأحيان التعامل مع هذه المستويات باستعاضةٍ من الفيبرية دونما تنظير نوعًا ما (وقد قيل أنّ ذلك ينطبق أحيانًا على حالة أعمال المؤرخ الاقتصادي الماركسي الفذ موريس دوب). إذن، فما حُدِّد هنا هو أمرٌ أشبه بـ «الالتقاء النظري»، يشتغل تارةً أو أخرى انطلاقًا من حججٍ تبدأ إما من القطب الماركسي أو الفيبري للمناظَرة.
وفي إحدى نقاط عمله المهمة يتحدى ريكس كلًّا من ماركس وفيبر – نقطةٌ يُصادَف أنّهما متفقان فيها، على ما يبدو. والنقطة هي زعم أنّ «العمل الحر هو الشكل الوحيد للعمل المتوافق على المدى الطويل مع منطق الرأسمالية العقلانية».[14] هذا الادعاء – القائم عند فيبر على تعريف النموذج المثالي المحدد لـ «العقلانية الرأسمالية»، وعند ماركس على تحليله التاريخي للمسار «المعياري» للتنمية الرأسمالية، استنادًا إلى الحالة الإنجليزية – يتحدّاه ريكس على الجبهتين. فهو بدلًا من ذلك يقول إنّ حالات الشذوذ التاريخي من هذا النوع «النمطي» تكرّر العثور عليها في التشكيلات الاجتماعية «استعماريّة النوع تحديدًا». فالغزو ومعه تشكيلةٌ من أشكالِ «العمل غير الحر» (المستند إلى أشكال لا-عقلانية ظاهريًّا من العلاقات الانتمائية، مثل تلك المستندة إلى الاختلافات العرقية) تخالف ذلك، إذ من الممكن أنْ تكون هي شروط الوجود لنشأة نمط إنتاجٍ رأسماليٍّ «ناجع» ونموّه. وما يقع وراء هذا التمييز التحليلي بلا شك هي نقطةٌ نظرية-سياسية، ألا وهي: رفضُ «التمركز الأوروبي» للماركسية، فيما تسقطه على التشكيلات الاجتماعية الأخرى من أشكال نمو ومساراتٍ وأشكال للمنطق خاصة بحالاتٍ أوروبية عُمِّمَت بنحوٍ غير مشروع (ويشار بالخصوص، طبعًا، إلى الحالة الإنجليزية، التي تشكل قاعدة التحليل في كتاب ماركس: «رأس المال»).
مع هذا التقويم المهم، لنا الآن أن نحدد النزعة السائدة لهذه التوليفة (فللفقرة التالية أن تمثل بالنيابة عن كثيرٍ من أخواتها في أعمال ريكس): «بالطبع، إحدى مشاكل تبني مصطلحاتٍ مثل «طائفة طبقية» 1الطائفة الطبقية (caste): تشير إلى المجتمعات المقسمة إلى طوائف مغلقة يحتل المنتمي لأيٍّ منها موقعًا اجتماعيًّا معينًا لا يتاح له الخروج منه (المترجم). أو «منزلة» 2(estate) منازل: مصطلح يشير إلى الطبقات الاجتماعية الأوروبية باستخدامها القديم المنقسم إلى ثلاث منازل: رجال الدين، والنبلاء والعامة (المترجم). . . . هي أنّ كلاهما يغفلان النقطة الجوهرية للتعريف الماركسي للإنتاج، أي: العلاقات بوسائل الإنتاج. ولكن ما نود أن نطرحه هنا ينصرف عن الماركسية البسيطة بمعنيين: إنه يعترف بأنه في مستوى العلاقات بوسائل الإنتاج مجالٌ ممكنٌ لمواقعَ واحتمالاتِ تشكيلاتٍ طبقية أوسع مما يبدو أن الماركسية الأوروبية البسيطة تتيحه. وثانيًا، بالإضافة إلى وسائل الإنتاج الفعلية، يوجد عددٌ من الوظائف والمواقع الاجتماعية، وأنّ هذه الوظائف تستحوذ عليها مجموعاتٌ مغلقة تملكُ – استنادًا لذلك – مصالحًا خاصة بها وموقع قوتها الخاص في مقابل المجتمع ككل». إذن فعندما يترجم هذا الموقف النظري «الماركسي بإضافة فيبرية» إلى مجال السياسية، يخرج بنوع حجّةٍ «ماركسية بإضافة فانونيّة».[15]
هذا الموقف، هذه التوليفة التي لخصناها أعلاه، انتُقدت بالطبع في سياق تطبيقها على جنوب أفريقيا. فعلى سبيل المثال، يشير وولب في مقالةٍ منشورةٍ مؤخرًا[16] إلى أنّ التمييز بين العمل «الحر» و«القسري» ليست طريقةً ملائمة لتصويرِ علاقات الإنتاج لتشكيلةٍ اجتماعية رأسمالية، مذ أنّ «العمل الحر» – بالنسبة لماركس – حتى في شكله الكلاسيكي ليس «حرًّا» إلّا بمعنى محدّدٍ جدًّا ورسميٍّ جدًّا: إنه على أيّ حالٍ خاضعٌ إلى الاضطرار الاقتصادي لبيع قوته العاملة كَسِلعة. وبالتالي في الحالة الجنوب أفريقية، مع أنّ زوج الحر/اللا-حر فعّالٌ في تمييز مُختَلف القيود التي تُهيكل تَوفَّر العمالة السوداء والبيضاء في السوق فهو ليس بالقوة النظرية التي تؤسس، عند العمالة السوداء، علاقةً بالإنتاج من نوعٍ متمايز مفاهيميًّا: «كل قوة العمل لا-حرّةٌ بطريقةٍ ما وبدرجةٍ ما، ونوع اللا-حرية أو درجتها أو استمرارية تأثيرها «يقتصر» على حدّة الاستغلال، لا نمطه».[17] وثانيًا هذا التمييز لا يشتمل على النقطة المركزية لماركس في «علاقات الإنتاج»، ألا وهي: نمط مصادرة فائض العمل. وثالثًا، إنّ منهجًا كهذا يجرّد سوق العمل وقيوده من علاقات نظام الإنتاج الفعلية، وهي واقعًا شاغلٌ مركزيٌّ للتحليلات الماركسية. ورابعًا، إنّ غياب تنظيرٍ لائق على مستوى نمط الإنتاج يتركنا مع تعريفٍ سياسيٍّ وأيديولوجيٍّ لـ «الطبقات» يسهل مجانسته بعد ذلك مع التجمّعات العرقية الرئيسة. والحقُّ أن أيّ تحليلٍ دقيقٍ لوضعية الطبقة العاملة السوداء والبيضاء في جنوب أفريقيا – وفق علاقاتهما المعقدة بنمط الإنتاج وتراتبهما الطبقي الداخلي – لن يأذن بـ «معالجة المجموعات العرقية» بصفتها «متجانسةً في تكوينها الطبقي». وولب هنا يوظف عمل غولييلمو كاركيدي الأخير حول تعريف الطبقات الاجتماعية، لكي يقول إنّ عدم التجانس في الوظائف (functions) بالنسبة لرأس المال لا يسلم منه أحدٌ، ولا حتى الطبقة العاملة البيضاء. خامسًا، يجادل وولب أنّ المواقف والوضعيات السياسية والأيديولوجية لا يمكن نسبها إلى كتلةٍ من الطبقات مُعرّفةٍ على المستوى الاقتصادي: «قد تتخذ طبقةٌ اجتماعية، أو جزءٌ أو شريحة من طبقةٍ، وضعية طبقية لا تتوافق مع مصالحها، ويعرّفها التحديد الطبقي الذي يضع أفق الصراع الطبقي».[18] والمثال المستشهد به هو مثالُ «الأرستقراطية العمّالية». وهذا يؤدي إلى حجّة أعمٍّ، مفادها أنّ تحليل الطبقات والصراع الطبقي يجب أن يبدأ من مستوى علاقات الإنتاج، عوضًا عن المعايير السياسية والأيديولوجية، لكنّ الأخيرة هذه لها أشكالها الخاصة من «الاستقلالية النسبية» لا يمكن إرجاعها إلى مكان طبقةٍ أو قطاعٍ طبقيٍّ في علاقات الإنتاج.
لا يعنيني هنا إجراء تقييمٍ مفصّلٍ لمحاسن هذه المقولات فيما يتعلق بالحالة الجنوب أفريقية، بل أود أن استخدم هذا الحوار كمثالٍ لأجل التقعيدِ لمقولةٍ أعم. فمقولات ريكس قد لا تكون وافيةً بحد ذاتها، ولكنها بلا شك تنتزع أرضًا فعّالة من ما يسميه «الماركسية البسيطة» – وهذا ما اضطر وولب للإقرار به. وهذه تمثل مكاسب نظرية حقيقية، ضد بعض نقاط ضعفٍ وثغراتٍ صارت الشكل السائد لتطبيق النموذج الماركسي الكلاسيكي. ولا تلغي هذه المكاسب كلّيًّا الإشارةُ (الصحيحة) إلى طرق تحريف ريكس أحيانًا لماركس، وتشويهه للفعالية النظرية الحقيقية لماركس. وثانيًا، يبين ردّ وولب أنّ نقاط الضعف هذه لا يمكن «تصحيحها»، والحفاظ على الخطوط العريضة الواسعة لمنهجية ماركسية، إلّا بتعديلٍ كبيرٍ للشكل السائد لتطبيق المنهجية الماركسية: إمّا بتطبيقٍ أدقٍّ وأصرم لبنود ماركس (التي تعرضت مرارًا مع الزمن لتبسيطات وإفقاراتٍ نظرية فظيعة) و/أو بتقديم أوجهٍ ومقولاتٍ نَدُر إيلاؤها دورًا مهمًّا جدًّا عند معالجة السمات الخاصة بالتشكيلات الاجتماعية ما بعد الغزو أو ما بعد الاستعمار، وإن كان من الممكن توضيح أنّها لا تناقض ماركس. واهتمامُ هذه الورقة المنصب على مقارباتٍ جديدة معينة لهذه المسائل، من داخل تطبيقٍ جديدٍ جوهريًّا للبنود الماركسية للتحليل، ينبع تحديدًا من انشغالٍ بتحديد أين وكيف بدأت هذه التشديدات الجديدة بالنمو.
وولب نفسه يتفق مع بعض النقاط على الأقل، فهو يقر أنّ ريكس «كان محقًّا في إصراراه على الحاجة إلى تصويرٍ أشمل وأنضح للطبقة عما تضمنته الإحالة العارية إلى علاقات الملكية». ولكن هذا – حسب وولب – يعني الابتعاد عن الاهتمام الذي يوليه ريكس لعلاقات السوق والقيود على عرض العمالة، نحو تحليلٍ أكمل لعلاقات الإنتاج وتحليل «أنماط الإنتاج». ويقر أنّ ريكس كان محقًّا في لفته الانتباه إلى الاختلافات المهمة في الشروط المؤثرة على دخول العمالة «السوداء» و«البيضاء» في سوق العمل، مع تحفّظٍ واحد مفاده أن التمييز بين العمالة الحرة وغير الحرة مطبّقٌ بنحوٍ مبالغٍ في الحدّية والتبسيط. ويقر أنّ ريكس يقدم نقطة ذات أهمية نظرية عظيمة أيضًا بِذِكره شكل «المساومة السياسية» بين الرأسمالي الأبيض والطبقات العاملة البيضاء، والدور الوظيفي «الإشرافي والبوليسي» اللاحق الذي تمارسه العمالة البيضاء على السوداء. ويَتْبع من ذلك أنّ بعض الوصفات السياسية التبسيطية المنطلقة من دعوة العمالة «السوداء» و«البيضاء» لترك اختلافاتهما جانبًا في نضالٍ طبقيٍّ مشتركٍ وعامٍّ ضد رأس المال – الدعوة الشهيرة إلى «الوحدة والقتال» – هي مطالب سياسية مجردة، مستندة إلى أسسٍ نظرية ضعيفة، مذ أنها لا تدرك بنحوٍ لائق العلاقتيْن المختلفتين بنيويًّا التي تحتلها كلٌّ من العمالة «البيضاء» و«السوداء» إزاء رأس المال.
والحق يقال، لعل وولب لم يوفي هذه النقطة حقّها، فالحجّة أكبرُ وإنْ لم تبدو كذلك. فريكس يجادل أنّ النظام الاجتماعي الجنوب أفريقي لا يظهر ميولًا قويّة أو «حتمية» نحو الإدماج التدريجي في الأشكال الأكثر «عقلانية» للعمل «الحر»، الأمر الذي طرح ماركس شَرطيّته اللازمة لتأسيس نمط الإنتاج الرأسمالي وإعادة إنتاجه. وريكس يجادل بهذا القول إنّ التقسيم العرقي للطبقات العاملة الجنوب أفريقية له قاعدةٌ حقيقيةٌ وصلبةٌ، بآثارٍ بليغة على المستوى الاقتصادي، إلى جانب المستوى السياسي والأيديولوجي. ويشير ريكس إلى الحاجة إلى تعريفٍ لـ «نمط الإنتاج الرأسمالي» قادرٍ على التعاطي مع «نماذج أخرى للاستغلال والمراكمة الرأسماليين وغير الرأسماليين» – أي بالأحرى: لمنظومة «رأسمالية» مؤسسةٍ تأسيسًا وثيقًا على أشكالٍ للعمل غيرِ العمالة الحرّة والمتحركة تقليديًّا. قد تُنتقَد هذه الصيغة، أخيرًا، بصفتها وصفيّةً بنحوٍ بالغِ التعددية. فهي تتجنب ضرورة تحديد آليات التمفصل، وأنماط السيطرة، بين هذه «الأنواع» المختلفة. ولكن ريكس نجح مجدّدًا وبجلاء في التشكيك بتحليلٍ مستند إلى التسليم بمسار كلاسيكيّ عامٍّ وضروريٍّ للتطور الرأسمالي، بتتابعٍ كلاسيكيٍّ لا رجعةَ فيه لمراحل تطورّية. بنحوٍ أوسع: إنّه يثير المسألة النظرية الحيوية للشكل الغائي والتطوريّ الذي فُسِّر به عملُ ماركس حول الشروط المسبقة الضرورية لتطور النمط الرأسمالي وخطِّ تطورهِ الأمثل – انطلاقًا من التأكيد الشهير، في «البيان الشيوعي»، بأن «البرجوازية . . . تُجبر كافة الأمم الواقعة على حافة الانقراض على تبني نمط الإنتاج الرأسمالي . . . فتخلق عالمًا على هيئتها»، وحتى النقاش الأسطوري حول «تتابع المراحل» الذي كثر استخراجه من الجزء حول «الأشكال السابقة للرأسمالية» في «الغرونديسة».[19] وضد هذا الاستقراء الغائي، يجب القول إنّ واقع الاستيلاء، وبالتالي حقيقة الشروط المختلفة جدًّا لإدراج الطبقات الاجتماعية السابقة للرأسمالية في النمط الرأسمالي، لم تؤدي – على العموم – دورًا مركزيًّا في إصدارات النظرية الماركسية التي اعتيدَ تطبيقها على مجتمعات ما بعد الغزو (وصعوبة التحديد الدقيق لطبيعة أنظمة العبودية الأمريكية – التي دُشِّنَت بوضوح داخل المرحلة الرأسمالية المركنتالية المتسعة ولكن بانفصالٍ منها – هي وجهٌ من أوجه المشكلة النظرية نفسها).[20]
وهذه إذن تمثل بعض مكاسب نقد ريكس على حساب ماركسيةٍ بالغةِ التبسيط. ما يعنيني تبيانه الآن هو كيف بدأت التنظيرات الماركسية الراهنة حول هذه المسائل، عبر نقدها الداخلي لما مُرِّر سابقًا كماركسيّةٍ «كلاسيكية» أو أرثودوكسية، بتصحيح بعض نقاط الضعف التي أشار إليها نُقّاد الاختزالية إشارةً صحيحة. وهذه الارتحالات ثريّةٌ ومعقّدة في الوقت نفسه، وهي في كثيرٍ من الأحيان في مرحلة صوغٍ أولية، وكما الحال عليه في اللحظات الحرجة لتحول النماذج، إنها مقيدة بنقاشٍ داخليٍّ دقيق. وليس لنا في هذه المراجعة إلّا أن نقدّم إشاراتٍ حول بعض الاتجاهات الرئيسة لهذه الأعمال.
لنا أن نبدأ هنا بالنظر في صيغةٍ بالغة التميّز معنية بتطور التشكيلات الاجتماعية لأمريكا اللاتينية، يصادف أنّها تعرّف نفسها ضمن ماركسيةٍ «كلاسيكية» وتُطوِّر، وفق ما يعتبر اتجاهًا ماركسيًّا، أحدَ أنواع الحجج التي يشكك بها نقدُ ريكس وغيره، وأعني هنا: عمل غندر فرانك، والانتقادات الأخيرة لعمل غندر فرانك ضمن منظورٍ ماركسيٍّ مُغَيَّر.
نجد إحدى التطبيقات المتميزة والبديعة لما يعتبر النموذجَ الماركسي عند غندر فرانك، وعمله عُدَّ نِدًّا للمدرسة السائدة والتأسيسية لِمنظِّري «التبعية»، المتجمّعين حول هيئة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية التي أسست في 1948. والمدرسة تبنّت تحليلًا أبلغَ بنيويّةً لتفسير «التخلف» والبلدان المتخلفة للمنطقة. وفي تضادها مع النماذج التنموية السابقة، شددت مدرسة الهيئة الاقتصادية على ضرورة معالجة التنمية والتخلف في الإطار الواحد لنظامٍ اقتصاديٍّ عالمي. والبلدان «المتخلفة»، بموجبه، هي القِطاعات التابعة في هذا النظام العالميٍ، أو على حدِّ قول كيلسو فورتادو: «يظهر أنّ نظرية التخلف هي في جوهرها نظريةُ تبعية».[21] ولدى نقطة الانطلاق هذه داخلَ إطارٍ اقتصاديٍّ عالميٍّ قواسم مشتركة كثيرة – بنحوٍ ماركسيٍّ «فضفاض» – مع أولئك الكتّاب الذين حاولوا التعاطي مع الجوانب الحديثة للتطور الرأسمالي على صعيدٍ عالميٍّ على نمط «نظرية للإمبريالية» (مثل: لينين، لكسمبورغ، هيلفيردنغ، بوخارين). سلَّمَ منظِّرو الهيئة الاقتصادية بإطارٍ عامٍّ للإمبريالية كهذا، ولكنهم ولّوا اهتمامًا أكبر من سابقيهم لآثارِ هذه المنظومة العالمية على أطرافها. ولم يكونوا ماركسيين بالضرورة في أي وجهٍ آخر. فهم جادلوا أن العلاقات العامة للتبعية هذه خلقت بنى داخلية تروج لشكلٍ سمّوه «التنمية الرأسمالية التابعة» وسط تلك القطاعات وتلك الطبقات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالسلسة الإمبريالية، وهمّشت قطاعاتٍ أخرى، منها الجماهير الواسعة من السكان، خصوصًا طبقة الفلاحين. «الاختلافات بين القطاع المُدوَّل والقطاع غير الصناعي أو الهامشي ناجمةٌ مباشرةً عن التوسع الرأسمالي وأصبحت نوعًا من الثنائية البنيوية».[22] ولكن «المدرسة» أنتجت عددًا من الاستراتيجيات المختلفة للتغلب على هذا الاختلال القطاعي ذو المنشأ الخارجي، وهي عادةً استراتيجياتٌ ذات طابع تكنيكي-اقتصادي، عوضًا عن سياسي.
لا شك أنّ غندر فرانك يتشارك مع منظِّري التبعية في ضرورة الابتداء من منظومة رأسمالية عالمية حيث التنمية والتخلف مرتبطان بنيويًّا، ولكنه جادل بصراحة ضد إمكانية برنامجٍ حقيقيٍّ أهليٍّ للتنمية الاقتصادية ذو – فلنقل – طابعٍ برجوازي-وطني، كمسارٍ ممكن لأمريكا اللاتينية لإنجاز الخروج من مرحلة التنمية التابعة. وهذه الحجة دعمها بأطروحةٍ مدهشة، تعيدنا إلى المشاكل المطروحة آنفًا. فقد جادل غندر فرانك أنَّ أمريكا اللاتينية أُدرِجت بالكامل في العلاقات العالمية الرأسمالية منذ حقبة غزو القوى الأوروبية في القرن السادس عشر، وأنّ تخلّفها نابعٌ من هذه الطبيعة التبعية لإدراجها الأولي في سوقٍ رأسمالية عالمية. ما تتضمنه هذه المقولة هو أنّ لا اختلافاتٍ بنيوية بقيت بين القطاعات الأكثر نموًّا والأقل نموًّا لتلك التشكيلات الاجتماعية. «التبعية» – حسب غندر فرانك – ليست ظاهرةً مستحدثة في المنطقة، بل هي ليست إلّا آخر أشكال «إتباع» (satellitizatiion) اقتصادات أمريكا اللاتينية ضمن إطار العلاقات الرأسمالية، ذلك أنّ «توسع المنظومة الرأسمالية عبر القرون الماضية ولجَ بنحوٍ فعّالٍ وكامل حتى في أشد القطاعات انعزالًا للعالم المتخلف».[23] والمفردة الأساسية لفهم ولوج علاقات الرأسمالية هذه وما أحدثته من تقويض، وما أدى لاستحضار الارتباط البنيوي بين النمو والتبعية كانت من استمراريةٍ واحدة: «استقطاب المتروبول/التابع» . . . «السيرورة التاريخية نفسها لتوسع الرأسمالية وتنميتها»، تستمر بتوليد «كلٍّ من التنمية الاقتصادية والتخلف البنيوي». وهذه السلسلة الإمبريالية «التي تمدّد الرابط الرأسمالي بين العالم الرأسمالي والمتروبولات الوطنية بمراكز قُطرية . . . ومن هذه المراكز المحلية وما إلى ذلك، إلى غيرها من كبار المّلاك والتجّار الذين يصادرون الفائض من الفلّاح الصغير أو المستأجر، وأحيانًا من الأخيرَين وإلى من يستغلّونَ من عمّالٍ محرومين من أراضي».[24]
النقد الأبلغ لعمل فرانك قُدِّم في نص مراجعة لإيرنستو لاكلاو بعنوان «الإقطاعية والرأسمالية في أمريكا اللاتينية»، الذي أعيد نشره في مجلّد لمقالاته نشر مؤخرًا.[25] يمكن تلخيص انتقاداتِ لاكلاو المحددة بسهولة. فموضوع نقده هو إصرار فرانك على أن أمريكا اللاتينية «رأسماليةٌ منذ البداية»، عمليةٌ واحدةٌ لا بد أنّها – بالنسبة لفرانك – «متماثلة بكل أوجهها منذ القرن السادس عشر وحتى العشرين». يبدأ لاكلاو بانتقاد تصور فرانك لـ «الرأسمالية»، فهو يعرفها كمنظومة إنتاجٍ لأجل السوق، حيث الربح يشكل الدافع المحرك. وهذا – حسب لاكلاو – مختلفٌ بنحوٍ أساسيٍّ عن مفهوم ماركس لنمط الإنتاج، فهو يفرّط بمعيار ماركس الرئيس الذي يعرف به «النمط»، ألا وهو: علاقات الإنتاج. وهذا «الخطأ» يقود فرانك إلى افتراض أنّه حيثما كانت مراكمة رأس المال، لا بد أن يتبعَها «قانون» ماركس: التحويل السريع والحتمي للتشكيلة الاجتماعية بعلاقات رأسمالية. ولكن بالنسبة لماركس، كما يبرهن لاكلاو، مراكمةُ رأس المال التجاري متوافقةٌ تمامًا مع أكثر أنماط الإنتاج تنوّعًا ولا تستلزم مسبقًا وجود نمطٍ رأسماليٍّ للإنتاج البتة، مثلًا: «لكن ليست التجارة وحدها بل حتى رأس مال التاجر أقدمُ من نمط الإنتاج الرأسمالي، وهي تاريخيًّا، في الواقع، أقدم حالة وجودٍ حرٍّ لرأس المال».[26] وهذا يقود لاكلاو إلى توجيه نقدٍ إضافيٍّ إلى ضعف التحديد التاريخي عند فرانك، حيث تدرج أوضاعٌ استغلاليةٍ مختلفة، مثل مؤكِّري (iquilinos) تشيلي وقَرويّي (hausipungeros) الإكوادور وعبيد مزارع الهند الغربية وعمّال مصانع نسيج مانشستر، ضمن علاقةٍ واحدةٍ يعلن أنها علاقةٌ «رأسماليّة». ويمكن قول الشيء نفسه وإن بتفصيل أكثر عن الحالة العويصة لعبودية المزارع في العالم الجديد. وهي بالطبع موقع مناظرةٍ طويلةٍ لم تُحَل بعد. وقد جادل أولريك ب. فيليبس – الذي رغم منظوره المسيء والمعادي للعبيد تلقى مديحًا مصيبًا من يوجين غينوفيس لتحليله الإبداعي للاقتصاد السياسي للعبودية – منذ مدة أنّ عبودية المزارع كانت شكلًا من أشكال الرأسمالية. وهذا كان حقًّا أساس اعتراضه عليها،[27] وقد ذهب غينوفيس نفسه إلى أنّ العبودية كان لها طقمٌ مميزٌ من العلاقات الاستغلالية: «مجتمعٌ مانورالي . . . خلقَ مجتمعًا فريدًا، ليس إقطاعيًّا . . . وليس رأسماليًّا». وأما باري هينديس وبول هيرست فيتصوران عبودية المزارع بصفتها «نمطًا» متمايزًا، مستخدميْن معايير شكلية أساسًا. ومن وقتٍ مبكر صبّ إيريك ويليامز ومن ثم غينوفيس وبناجي من بين آخرين تركيزهم على العلاقة بين عبودية المزارع – أيًّا كان «نمطها» المميز – والاقتصاد الرأسمالي العالمي. وقد وصف كلٌّ روبيرت فوغل وستانلي إنغرمان مؤخرًا العبودية كشكلٍ مربحٍ من «الزراعة الرأسمالية».[28]
يقتبس فرانك ملاحظات ماركس التي تصف المزارع كـ «مقامرات تجارية، مراكز إنتاج للسوق العالمية» كدليلٍ على أن ماركس اعتبرها هي الأخرى «رأسمالية»، فيذكرنا لاكلاو أنّ ماركس أنهى كلامه بالقول «وإن بصورةٍ شكليةٍ فحسب». يبدو أن مقولة ماركس واقعًا كانت نقيضًا لمقولة فرانك، فالأول يصرّ أنّ المزارع الاستعبادية لا يمكن أن تكون إلّا «رأسمالية شكليًّا»، «مذ أنّ العبودية عند الزنوج تستثنني العمالة الحرة المأجورة، وهي الأساس الذي يستند إليه الإنتاج الرأسمالي. ولكن من يتعاملون بالنخاسة رأسماليون». وكما جادلت بيتشي مؤخرًا،[29] لا شك أن العبودية استلزمت مسبقًا الملكية الخاصة، وطبقةً من المُلّاك، وطبقةً غير مالكة. ولكن بينما يملك العامل تحت الرأسمالية قوّة عمله التي يبيعها كسلعةٍ للرأسمالي، يملكُ مالكُ العبيد كلًّا من قوة العمل والعبد. «مالِك العبيد يعتبر الزنجي، الذي اشتراه، ملكًا له، ليس لأنّ مؤسسة العبودية بعد ذاتها تملّكه هذا الزنجي، بل لأنّه اقتناه مثل أي سلعةٍ أخرى عبر البيع والشراء».[30] ولكن كلًّا من النخاسة نفسها واستخراج السلع المنتجة عبرها مَوّلهما رأس المال المركنتالي ودارا في الدوائر العالمية لرأس المال. فكما توضح بيتشي ببصيرة عظيمة: «كان مُلّاك العبيد تجّارًا، يتعاملون بشراء السلع وبيعها في سوقٍ عالمية، وَمُلّاك عبيدٍ يستغلون عبيدهم في نظام المزارع، الذي نشأ كمنطقة زراعية متخصصة؛ نوعٌ من أنواع المستعمرات الداخلية داخل السوق العالمية الموسعة».[31]
ما يصفه ماركس إذن كان شيئًا مختلفًا جذريًّا عن تفسير فرانك، وتحديدًا: التمفصل بين نمطين للإنتاج، أحدهما «رأسمالي» بالمعنى الحقيقي، والآخر «شكليٌّ» لا غير: تركّب الاثنان عبر مبدأ تمفصل، آليةٌ، أو حزمة من العلاقات، لأن «المنتفعين منها»، كما لاحظ ماركس، «يشارِكون في سوقٍ عالميٍّ حيث القطاع الإنتاجي المسيطر رأسماليٌّ بالفعل». أي أنّ موضوع البحث يجب معالجته كبنية متمفصلة معقدة هي، بحد ذاتها، «مبنيةٌ بِسائد». وبالتالي فمُلّاك المزارع الاستعبادية شاركوا في حركة عامة للمنظومة العالمية الرأسمالية، ولكن على قاعدة نمطٍ داخليٍّ للإنتاج – العبودية في شكلها الزراعي الحديث – ليس ذا طابع «رأسمالي» بحد ذاته. هذه فرضيةٌ ثوريةٌ بالمعنى النظري، لأنها تهجر القراءةَ بالغةَ الغائيةِ لماركس التي أنتجت – عند فرانك – أطروحةً لا يمكن تبريرها مفادها أن أمريكا اللاتينية كانت «رأسمالية» منذ الغزو. ما يبقى لدينا، خلافًا لأطروحة «التحول الحتمي» للأنماط السابقة للرأسمالية وتذويبها بالعلاقات الرأسمالية، هي المشكلة النظرية الناشئة حول تمفصل مختلف أنماط الإنتاج، المبنية في علاقةِ سيادة. وهذا يقود إلى تعريف تشكيلة اجتماعية قد تكون، في مستواها الاقتصادي، مكونةً من عددٍ من أنماط الإنتاج، «المبنية بسائد».[32] وهذا وفر قاعدةً لكمٍّ مَهولٍ من العمل الريادي، خصوصًا حول «أنماط الإنتاج السابقة للرأسمالية»، موفرًا منهجًا أكثر صرامةً من تلك القراءة لماركس، التي انتقدها ريكس محقًّا – بهذه النقطة تحديدًا – مع الحفاظ على البنود المنظومية لتحليلٍ ماركسي. وهذا العمل بالطبع طُرِح أساسًا على مستوى العلاقات الاقتصادية. ورغم وضوح الآثار على المستويات الأخرى لبنية التشكيلات الاجتماعية (التشكيلات والتحالفات الطبقية، والبنى السياسية والأيديولوجية، إلخ)، فهذه الآثار لم تُشرح (مثلًا في مقال لاكلاو المقتبس هنا: إنما بسبب تطورات أخيرة معنية بهذه المستويات، أنظر لاكلاو وغيره ممن أحيلُ إليهم بكثافة أدناه)، فلها على سبيل المثال آثارٌ مهمة على أي تحليلات عن كيف يُدخِل الارتباطُ المتمفصل للأنماطِ، فاعلينَ اقتصاديين، منتشَلينَ من مجموعات إثنية مختلفة، في مجموعةٍ من العلاقات الاقتصادية، رغم تمفصُلها في اتحادٍ مُعقّدٍ، يجب ألا تصوَّر على أنها متماثلةٌ بالضرورة أو قُدِّرَ لها حتمًا أن تصير كذلك.
هذه الإشكالية الناشئة تشكل على الأرجح التطوّر الأكثر توليدًا في الحقل، مؤثرةً على تحليل التشكيلات الاجتماعية المبنية عرقيًّا. والموقف النظري الناشئ هذا، يُرجِع مناصروه أرضيته إلى «إعادة قراءة» معينة للأدبيات الماركسية الكلاسيكية. إنها جزءٌ من تلك الثورة النظرية المهولة التي كونتها العودة المعقدة إلى «قراءة» «رأسمال» ماركس التي حملت وقعًا فكريًّا رياديًّا خلال العقد الماضي، وهي الآن في طور النمو في عدد من الحقول النظرية المختلفة. يقدم لاكلاو الحجة بشكلٍ قوي: «الطابع ما-قبل الرأسمالي للعلاقات السائدة للإنتاج في أمريكا اللاتينية لم يكن فقط متوائمًا للغاية مع الإنتاج لأجل السوق العالمية، بل توسّعُ السوقِ عظّمهُ واقعًا». فماركس تحدث – في فقرةٍ أقل شهرةً من «سيناريو» البيان الشيوعي المقتبس أعلاه – عن حقيقة هي: «تتقاطع دورة رأس المال الصناعي. . . مع تداول السلع المُنتَجة في أشدِّ أنماط الإنتاج الاجتماعي تنوّعًا. . . . وسيّان إنْ كانت السلع من مخرجات إنتاج يرتكز إلى العمل العبودي، أم منتوج فلّاحين. . .أم منتوج دولة. . .أم أقوام صيدٍ شبه همجية. . .[فهي] تقف وجهًا لوجه مع النقد والسلع التي يتمثل فيها رأس المال الصناعي. . . . أما طابع عملية الإنتاج التي تنبثق منها فلا أهمية له. . . . [فمن] الواجب أن يعاد إنتاجها، وفي هذه الحدود يكون نمط الإنتاج الرأسمالي مشروطًا بأنماط إنتاج تقع خارج مرحلة تطوره».[33] يجادل شارل بتلهايم – وإن بدا وكأنه يتخذ منظورًا أكثر «كلاسيكية» – أن الميل السائد متجه نحو تذويب النمط الرأسمالي للأنماط الأخرى. ولكن هذا الميل يكثر أن يجاوره ميلٌ ثانوي، ميلُ «التذويب الحِفظي»: فيه الأنماط غير الرأسمالية «قبل أن تختفي «يُعاد بِناؤها» (تذوّب جزئيًّا) ومن ثم تُخضَع إلى العلاقات الرأسمالية السائدة (وبالتالي تُحفَظ)».[34]
يبين وولب باستخدام هذه الخطوط أن مشاكلَ معينة للتشكيلة الاجتماعية الجنوب أفريقية (أشيرَ إليها أعلاه) لم تقبل التفسير بشكلٍ وافٍ ضمن القراءة القديمة (التي أصاب ريكس وغيره في انتقادها) غدت قابلةً للحل عبر استخدام هذه الأدوات النظرية الجديدة وبنحوٍ يسلّط ضوءًا قويًّا على التقسيم العرقي للعلاقات الطبقية في جنوب أفريقيا. وبينما الخطوط العريضة المفصّلة لمحاولة «الحل» هذه لا يمكن الخوض فيها هنا،[35] فآثارها الواسعة تستحق الاقتباس. فوولب يوحي مثلًا بأن اتّكال القطاع الرأسمالي في جوب أفريقيا على قطاعاتٍ غير رأسمالية في المناطق الأفريقية لأجل توفير العمالة الرخيصة وإعادة الإنتاج الكفافية، يمكّنُ رأسَ المال من التسديد لقوّة العمل بأدنى من قيمة إعادة إنتاجها، في حين يملك إمداداتٍ وفيرة من العمالة متوفرة دائمًا ولا يتحمل كامل تكلفة كفافها.[36] وهو هنا يوظّف سلالةَ «التمفصل» و«الحفظ المُذَوِّب» للأطروحة. في جنوب أفريقيا يتقاطع ميل مراكمةِ رأس المال إلى تذويب الأنماط الأخرى مع الميول الوازِنة لحفظ الاقتصادات غير الرأسمالية فتحجبه – على أساس أنّ الأخيرة هذه متمفصلةٌ بموقعٍ خاضعٍ للأول. وحيثما تنبثق الرأسمالية – جزئيًّا – عبر تمفصلها بأنماط غير رأسمالية، «فنمط السيطرة السياسية وفحوى الأيديولوجيات المشرْعِنة تتخذ أشكالًا عرقية، إثنية وثقافية، وللسبب نفسه في حالة الإمبريالية . . . تتخذ السيطرة السياسية شكلًا استعماريًّا».[37] ويضيف: «حفظ الأنماط غير الرأسمالية للإنتاج يستلزم بالضرورة تطويرَ أيديولوجياتٍ وسياساتٍ سياسيةٍ تتمحور حول فصل المجتمعات «القَبَلية» الأفريقية وحفظها والتحكم بها» – أي أنّ العلاقات تتخذ أشكال أيديولوجيّاتٍ مبنيةٍ حول عناصر أيديولوجية إثنية، وعرقية، وقومية، وثقافية.
باختصار، تبدأ النظرية الناشئة لـ «تمفصل الأنماط المختلفة للإنتاج» بتقديم آثارٍ معينةٍ مهمةٍ لتحليل العنصرية على الأصعدة الاجتماعية والسياسية والأيديولوجية. وهي لا تبدأ بتفعيل هكذا آثارٍ – وهذه النقطة حيوية – عبر هجر مستوى تحليل العلاقات الاقتصادية (أي: نمط الإنتاج) بل بطرحه في شكله الصحيح، المعقّدِ بالضرورة. وبالطبع فنقطة الانطلاق هذه قد تكون ضروريةً ولكنها غير وافية. فبهذا الصدد، مصطلح وولب، «يستلزم»، فيه إفراط، لإيحائه بتناظرٍ ضروريٍّ، ذا نوعٍ بالغ الوظيفية، بين بُنية أنماط الإنتاج والأشكال المخصصة للسيطرة السياسية والشرعنة الأيديولوجية. ومستوى التحليل الاقتصادي، بعد إعادة التعريف المفرطة، قد لا يوفر شروطًا وافية بحد ذاته لشرح نشأة العنصرية واشتغالها. ولكن ذلك يوفر على الأقل نقطة انطلاقٍ أفضل وأسلم من تلك المقاربات المضطرة لهجرِ الصعيد الاقتصادي، لكي تنتج «عوامل إضافية» تشرح أصل البناءِ العرقي وظهورهُ على مستوياتٍ أخرى من التشكيلة الاجتماعية. وبهذا الصدد على الأقل إنّ التقدمات النظرية التي شرحنا خطوطها العريضة بإيجازٍ هنا لها مثلبة احترامِ ما سنسميه المقدمات الأساسية لـ «طريقة» ماركس: المقدمة المادية، ومفادها هو أن تحليل البنى السياسية والأيديولوجية يجب أن يوضع على أرضية الشروط المادية للوجود، والمقدمة التاريخية، ومفادها أن الأشكال الخاصة لهذه العلاقات لا يمكن استنباطها، قَبْليًّا، من هذا المستوى بل يجب تمييزها تاريخيًّا «بتوفير تلك الترسيمات الحدودية الإضافية» التي تشرح ميزتها. وكلا المقدمتين مطروحتان طرحًا بديعًا في الفقرات المستحِقّة لشُهرتِها من «رأس المال»: «إن الشكل الاقتصادي المتميز لاعتصار العمل الفائض غير مدفوع الأجر من المنتجين المباشرين، يحدد علاقة السيد-الخادم بصورة تنمو بها مباشرة من الإنتاج نفسه، ثم تؤثر فيه، بدورها، كعنصرٍ مُحدِّد. ويقوم على ذلك كامل تشكيلة نظام الجماعة الذي ينمو من علاقات الإنتاج نفسها، وكذلك تركيبه السياسي المتميز في الوقت نفسه» (المقدمة المادية). ولكن «هذا لا يمنع القاعدة الاقتصادية الواحدة نفسها – نفسها من ناحية الشروط الأساسية – بِفِعل عددٍ لا يحصى من الظروف الإمبريقية المتنوعة، والبيئات الطبيعية، والعلاقات العرقية، والمؤثرات التاريخية الخارجية، إلخ، أن تُبدي في تجلّيها صورًا وتدرّجات لا نهائية، لا يمكن إدراكها إلا عبر تحليل هذه الظروف المُعطاة إمبريقيًّا» (المقدمة التاريخية).[38] كلا المقدمتين لازمتانِ بالفعل لإيفاء شروط الملاءمة النظرية، لكنّ الواحد منهما، وحدهُ، ليس كافيًا. فالأول، دون الثاني، قد يرجعنا مباشرةً إلى مأزق الاختزالية الاقتصادية، والثاني، دون الأول، سيقيّدنا بمهالك النسبية التاريخية. طريقة ماركس، إن فُهِمت وطُبِّقت بنحوٍ لائق، تمنحنا شروطًا ملاءمةً نظريةً تتجنب الاثنين – دون أن تضْمن ذلك بالطبع.[39]
كان لتطبيق أطروحة «التمفصل»، الملخصة هنا، آثار نظرية ثورية على حقول البحث الأخرى لا يسعنا إلا ذكرها بإيجازٍ هنا لأنها خارجة عن شاغلنا الأساسي، ولنا أن نجدها – في السياق الإنجليزي – في الأعمال حول «الأنماط» والتشكيلات الاجتماعية «السابقة للرأسمالية»، من هيندس وهيرست،[40] بناجي،[41] وفي الأدبيات المنشورة مؤخرًا حول «الأنماط الاستعمارية للإنتاج»،[42] وفي الإصدارات الأخيرة من مجلات مثل «مجلة الاقتصاد السياسي الأفريقي» (Review of African Political Economy)، و«نقد الأنثروبولوجيا» (Critique of Anthropology)، و«الاقتصاد والمجتمع» (Economy and Society)، وبشكل متّصلٍ في المناظرات المتجددة حول «النقلة»، التي أشعلها إعادة إصدار مجموعة النصوص الريادية حول «النقلة من الإقطاعية إلى الرأسمالية»،[43] والنص الذي سينشر قريبًا لكين بوست.[44] وأبرز ما يلحظ في فرنسا يقع في سياق إنعاش الاهتمام في «الأنثروبولوجيا الاقتصادية» الجديدة التي قدم فيها كتّاب مثل موريس غودليير وكلود ميلاسو وإيمانويل تيري وبيار-فيليب راي وجورج دوبريه مساهماتٍ مهمة.[45] ميلاسو يعالج تحديدًا موضوع التشكيلات الاجتماعية الزراعية «المستدامة ذاتيًّا»، وتحوّلها الذوباني، حينما تطعّمت بالإنتاج لأجل الأسواق «الرأسمالية» الخارجية. ولهذا الأمر تداعياتٌ نظرية معينة على تلك التشكيلات الاجتماعية المتمفصلة حيث القطاع غير الرأسمالي «قادرٌ على تلبية وظائف تفضل الرأسمالية ألا تأخذها على عاتقها في البلدان متخلفة النمو» (أنظر تطوير وولب لهذه المقولة أعلاه) ومن ثم للمجتمعات مثل المجتمع الجنوب أفريقي، حيث، وفق استقراء جون كلامر، «يجبر الناس الذين ألزموا بأن يصيروا عمّالًا مأجورين في وضعٍ استعماريٍّ جديدٍ أو شبه استعماري، على العودة إلى القطاع «التقليدي» للحصول تحديدًا على تلك الخدمات التي لا يوفرها الرأسمالي». ويشير كلامر بنحوٍ صحيح إلى أنّ هذا يحيي التحليل «ذو القطاعين» – إنما بشكلٍ جديدٍ جذريًّا، فمثلما يقول ميلاسو: الوظيفة الأيديولوجية لنظريات «القطاعيْن» هي على وجه التحديد «إخفاء استغلال الجماعة الريفية، المدمجة كعنصرٍ عضويٍّ للإنتاج الرأسمالي».[46]
يتعاطى عمل راي بنحوٍ رئيسٍ مع مجتمعات «سلالية»، وهو، مثل ميلاسو، يستمد من عملٍ ميدانيٍّ أفريقيٍّ، لكن استقراءاتٍ أوسع ذات طبيعةٍ نظرية أقيمت على تضاريس هذا العمل.[47] وهي تختلف عن أعمال أخرى داخلة ضمن من تقليد «الأنثروبولوجيا الاقتصادية» الفرنسية بانشغالها، جزئيًّا، في مشاكل تمديد حجة «التمفصل» – كما يتبين في عنوان كتابه الثاني – لتشتمل على مسألة التحالفات الطبقية، وبالتالي على المستوى السياسي. وراي ينصرف بعض الشيء عن إشكالية «التمفصل». فهو منشغلٌ بـ «الأثر المتماثل» (homoficence) للرأسمالية – ما يسميه أيدان فوستر-كارتر «توازي عمل» الرأسمالية،[48] ليقدّم بذلك مراجعةً/نقدًا أعمقَ لكلٍّ من راي وأدبيات «التمفصل». ولكن في عمل راي تميّزٌ كبيرٌ يتمثل في محاولته تحقيب «توازي العمل» هذا كسيرورةٍ، في مراحلَ ثلاث رئيسة، يُعَلّم كلًّا منها بطابع تمفصلها. وهذه المراحل هي: (1) مرحلة تجارة الرقيق، حيث استحوذ السوق الأوروبي على الإمدادات، عبر علاقات مبادلة، «جوهريًّا، بالتلاعب بالتناقضات الداخلية للتشكيلات الاجتماعية السلالية»، (2) مرحلةٌ انتقالية – الاستعمار بمعناه الكامل – حيث تضرب الرأسمالية جذورها في أرضية النمط السابق للرأسمالية وتخضعه بالتدريج، (3) نوع جديد للتشكيلات الاجتماعية، حيث النمط الرأسمالي للإنتاج مسيطرٌ، وفي حالاتٍ كثيرةٍ، يكون تابعًا لرأسمالية ميتروبولية (الاستعمار الجديد). ويصاحب كلّ مرحلةٍ مجموعةٌ مختلفة من التحالفات الطبقية. ونجد راي منشغلًا أيضًا بإخلال المجتمعات السلالية وفكِّ تمفصلها من قِبل القوة الخارجية للرأسمالية – في أحيانَ كثيرة بالعنف، وبما أسماه ماركس «واقعُ الاستيلاء».[49] يرى راي في «ضرب جذور» الرأسمالية في الأنماط السابقة للرأسمالية أمرًا ممكنًا فقط بتطبيق «الأنماط الانتقالية» – وهي تحديدًا وظيفةُ الحقبة الاستعمارية. وبإعطائه هذا الطور دورًا أصيلًا لا يُمْنَح له عادةً، أو حتى يميّز به، تَتْرك مقاربةُ راي تاريخَ رأسمالية وآلية الانتقال كتاريخٍ «مكتوبٍ [غالبًا] خارج مثل هذه التشكيلات الاجتماعية»، وتاريخٌ يميل لمعالجة علاقات المبادلة بصفتها السمة المُمَفصِلة الرئيسية.[50]
مفردة «التمفصل» مفردةٌ معقدةٌ، تُوَظَّف وتعرّف بتنوّعٍ في الأدبيات المذكورة. ولا يمكننا القول إنّه قد وُصِلَ إلى توافقٍ واضحٍ على التعريف المفاهيمي. ولكن المفردة ما زالت محلَّ إحداثِ قطيعةٍ (coupure) ومُداخلةٍ نظريّتينِ كُبْريين. وهذه المداخلة تُربَط بنحوٍ رئيس بأعمال ألتوسير و«مدرسة» الماركسية البنيوية. والمفردة توظف توظيفًا واسعًا – في عدد من السياقات – خصوصًا في مقالات «لأجل ماركس»،[51] وفي المجلد اللاحق، مع إتيان باليبار، «قراءة رأس المال».[52] ويهمّنا بنحوٍ خاصٍّ هنا على الأقل تطبيقانِ مختلفان (ومع ذلك، من المثير للاهتمام أن المفردة لم تُعرّف في «الفهرس»، الذي حضّره بين بروستر وصادق عليه ألتوسير نفسه، وظهر على الطبعة الإنجليزية للكتابين). وإلى جانب هاذين الاستخدامين المحددين، للمفردةِ مرجعيةٌ أوسع ذات طبيعة نظرية ومنهجية أيضًا.
يقترح فوستر-كارتر مُحقًّا أن التمفصل مجازٌ يستخدم «للإشارة إلى علاقة ارتباطٍ وتأثُّر بين المستويات المختلفة لطيفٍ واسع من الأشياء» – ولربما كان عليه أنْ يضيف أن هذه الأشياء تستلزم الربط لأنها رغم اتصالها، فهي ليست الشيء نفسه. إنّ الوحدة التي تشكلها ليستَ إذن وحدةَ تماهٍ، حيثُ بنيةٌ واحدةٌ تلخّص بنية أخرى أو تعيد إنتاجها أو حتّى «تعبّر عنها» بنحوٍ كامل، أو حيثُ كلّ بنيةٍ تقبل الاختزال في الأخرى، أو حيث كلّ واحدةٍ تعرّفها نفسُ المحدِّدات أو تمتلك شروط الوجود نفسها تمامًا، أو حتى حيث كلُّ واحدةٍ تتطور بموجب أثرِ نفس شروط الوجود، أو حتى حيث كلّ واحدة تتطور بموجب أثر التناقض نفسه (مثل «التناقض الرئيس» المحبوب، كمذكّرةِ كافة الحجج وضمانِها، لدى من يلقَّبون بالماركسيين «الأرثوذكسيين»). إنّ الوحدة التي يشكّلها هذا التراكُب أو التمفصل هي دائمًا وبالضرورة «بُنية معقدة»: بنيةٌ حيث ترتبط الأشياء، عبر اختلافاتها وتشابهاتها بالقدر نفسه. وهذا يستلزم إثبات الآليات التي تربط السمات غير المتشابهة – إذ لا يمكن افتراضُ وجود «تناظرٍ ضروري» أو ندّية تعبيرية كأمرٍ معطى. وذلك يعني أيضًا – مذ أن الارتباط هو بُنيةٌ (ارتباطٌ متمفصل) وليس ارتباطًا عشوائيًّا – أنّ لأجزائها علاقاتٌ بنيوية، أي: علاقاتُ سيطرةٍ وتبعية. وهنا تأتي عبارة ألتوسير المُبْهمة، «وحدةٌ معقدة، مبنيّةٌ بِسائد».
تتلخص العديد من الموضوعات الكلاسيكية للمداخلة الألتوسيرية في استخداماته المتنوعة للمفردة وبها، فمثلًا: قوله إنّ «وِحدة» ماركس ليست «الوحد التعبيرية» الجوهرانية الموجودة عند هيغل، وأنّ جدلية ماركس – بناءً على ذلك – ليست محض قلبٍ لِهيغل، بل تجاوزٌ نظريٌّ له. وهذا النقد الموجه للنظر إلى «كلّية» ماركس بصفتها «كلّية تعبيرية»، هو ما يضع نقد ألتوسير المبكر لمحاولات إنقاذ عمل ماركس من «المادية الفجة» بتحويلةٍ عبر الهيغلية (أنظر «لأجل ماركس» لألتوسير، وخصوصًا فصل «حول الجدلية الماركسية»). ويؤسس ذلك لِنقد ألتوسير لمحاولة قراءة ماركس وكأنه قصدَ أنّ كافة البنى لتشكيلةٍ اجتماعية يمكن اختزالها في «تعبير» عن البنية الاقتصادية، أو كأن كافة أوجه أي نقطةٍ حرجة (conjuncture) تاريخية تحرَّكت في علاقةٍ توافقٍ مباشر مع بنود «التناقض الرئيس» (أي، «القاعدة»، بين قوى الإنتاج وعلاقاته) – وهذا هو نقد ألتوسير (المعاكِس لنقده للمثالية الهيغلية) ضدّ «الاختزالية الاقتصادية». فألتوسير يجادل أنّ «الوحدة المعقدة» لماركس ليست وحدةً حيث كلّ شيءٍ يعبرُ عن كل شيءٍ آخر أو يتوافق معه بنحوٍ كامل، وليست وحدةً حيث كل شيء يقبل الاختزال في تعبيرٍ عن «الاقتصادي». فهي تشتغل بدلًا من ذلك على تضاريس التمفصل. وما نجدهُ في أيّ نقطةٍ حرجةٍ تاريخية محددة (والمثال الذي يوظفه في «التناقض وفرط التحديد»، في «لأجل ماركس»، هو روسيا عامَ 1917) ليس انبساط «التناقض الرئيس»، بنحوٍ متكافئ، على كافة المستويات الأخرى للتشكيلة الاجتماعية، بل – بتعبير لينين نفسه – «اندماجُ» التناقضات و«قطيعتها» وتركّزها، كلّ تناقضٍ بخصوصيته وتحقيبه المحدد – «تياراتٌ ليست متماثلة على الإطلاق، ومصالحُ سياسية ليست متناغمة على الإطلاق، ومساعٍ اجتماعية وسياسية متناقضة تناقضًا مطلقًا» – «اندمجت . . . بنحوٍ «متناغمٍ» لافت».[53] ونقاطٌ حرجةٌ كهذه ليست «محدَّدةً» بقدر ما هي مُفرطَة التحديد (overdetermined)، أي أنها نتيجة تمفصلٍ للتناقضات، لا تقبل الاختزال في أيٍّ منها مباشرةً.
يوظف ألتوسير وباليبار إذن هذا المفهوم النظري العام في عدد من السياقات المختلفة. فهما يتصوران تشكيلة اجتماعية مكونةً من عدد من اللحظات – كلٌّ بدرجةٍ من «الاستقلال النسبي» عن الأخريات – متمفصلةً في وِحدةٍ (متناقضة). واللحظة أو المستوى الاقتصادي بحدّ ذاته هو نتيجةٌ لهكذا «ارتباط»: تمفصلُ قوى الإنتاج وعلاقاته. وقد تكون تشكيلاتٌ اجتماعيةٌ محددةٌ – خصوصًا أثناء حقب «الانتقال» – عبارةً عن «ارتباطٍ متمفصلٍ» لأنماط مختلفة ذات بنودِ تراتبٍ هرميٍّ محددةٍ ومتقلبةٍ. والمفردة داخلةٌ أيضًا في الأبستمولوجيا الألتوسيرية، التي تصر على أن المعرفة وإنتاج المعرفة لا يُنتَجانِ بانفصال، كانعكاسٍ إمبريقيٍّ للواقعي «في الفكر»، بل لها خصوصيّتها واستقلاليّتها – الفكر، «قائمٌ على أساسٍ من العالم الواقعي لمجتمعٍ تاريخيٍّ معين، ومتمفصلٌ معه».[54] إن التحليل العلمي لأي تشكيلة اجتماعية محددة يعتمد على الإدراك الصائب لمبدئ تمفصُلِها: «المفصل» بين اللحظات المختلفة، والحقب والفترات المختلفة، بل وحتى مختلف التمرحلات، أي: الأزمان والتواريخ. والمبدأ نفسه يُطبَّق، ليس بتزامنٍ فحسب، بين الأوجه والتحقبيات داخل أي «لحظة» لبنيةٍ ما، بل حتى بنحوٍ لا-تزامني، بين مختلف «اللحظات». وهذا يتصل مع اعتراضِ ألتوسير على الفكرة القائلة بوجود تسلسلٍ معطىً وضروريٍّ لمراحل، بتقدّمٍ ضروريٍّ مدمجٍ فيها. ويصر على قراءةٍ لا-غائية لماركس، بناءً على فكرة «التوالي المنقطع لأنماط الإنتاج»،[55] تواليها المرتبط – أي تمفصلّها عبر الزمن – يستلزم الإثبات. بل و«الصفة العِلميّة» (scientificity) بحد ذاتها متعلقة بـ «مشكلة أشكالِ التنوع والتمفصل» لجوانب كل بنيةٍ اجتماعية.[56] يمكن قول الشيء نفسه حول العلاقة بين الأشكال الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية لمظهرها. وهذه فُكِّرَ بها وفق تشبيهِ التمفصل بين بنى لا تعبّر عن بعضها البعض مباشرةً ولا تعكس بعضها البعض كالمرآة. وعليه فالمشكلة الكلاسيكية للماركسية – مشكلة تحديديّة البُنية، «التحديد في اللحظة الأخيرة من الاقتصادي» (ما يميز الماركسية من أنواع التفسير العلمي الاجتماعي الأخرى) – يعاد تعريفها هي نفسها كمشكلة «تمفصل». ما «يُحَدَّد» ليس الشكل الداخلي لكل مستوى ومظهرهُ، بل نمط ترابط وتموضع كل لحظة في علاقةٍ متمفصلة مع بقية العناصر. و«تمفصل البنية» هذا كالأثر العالمي للبنية نفسها – أو ما سمّي، من باليبار، بـ «الدور المصفوفي لنمط الإنتاج» – هو ما يعرف المفهوم الألتوسيري للتحديد بصفتهِ سببيةً بنيويةً.[57] وهذا التصور من جانب آخر هو ما قدم الأساس لنقدِ هنديس وهيرست[58] لمقولة ألتوسير عن «تَحَدُّدِ التمفصلِ بالبنية» بصفتها، هي نفسها، «كلّيةً تعبيرية» – أبدية سبينوزية. ففي تعامل باليبار مع مثال العلاقة بين أجر الأرض الإقطاعي والعلاقة الإقطاعية اللوردية (lordship) والاسترقاق (servitude)، يعالجها كمثالٍ مختزلٍ لتمفصل حالتينِ مختلفتين، لحظةٌ «اقتصادية» ولحظةٌ «سياسية». وبالمثل يعرف باليبار مفهوم نمط الإنتاج نفسه، كنتيجة لارتباطٍ متنوّعٍ للعناصر (موضوع العمل، وسائل العمل، قوة العمل). فما يتغير، في كل عصر، ليس العناصر، وهي لا تتنوع (بالمعنى التعريفي)، بل طريقة ارتباطها: تمفصلها. وبينما من غير الممكن «قول» كامل المداخلة الألتوسيرية وفق بندِ مفهومٍ واحد، مثل التمفصل، فلا بد من أنّه من الواضح جدًّا أن للمفهوم مرجعيةٌ واسعة ومكثفة في أعمال الماركسيين البنيويين.
وإن لم يسعنا هنا الخوض في الخلفية النظرية والمنهجية لنشأة هذا المفهوم، فبإمكاننا على الأقل الإشارة العابرة إلى منبعين مهمّين. الأول هو منبع اللسانيات البنيوية، الذي وفر النموذج-السيد لجزءٍ معتبر من المشروع «البنيوي» بأكمله. دي سوسور، «مؤسس» هذه المدرسة، وقوله أنّ اللغة ليست انعكاسًا للعالم بل تُنتج المعنى عبر تمفصُلِ الأنظمة اللغوية مع العلاقات الحقيقية، يصرّ على أنّ المعنى ليس محض «ترابطٍ بين الدال والمدلول، بل لعله في جوهره أقرب إلى فعل القطع المتزامنِ لكُتلَتين هلاميّتين (amorphous)، «مَملكتين طافيتين». . . اللغة هي نِطاق التمفصُلات».[59] ولعلّ المنبع الأهم هو الإجازة التي وجدتها ألتوسير وغيره في نصِّ ماركس الأشد «منهجيةً» («مقدمة الغروندريسة لعام 1857») لنظريةٍ للتشكيلة الاجتماعية أعيد مرجعها إلى ما أسماه ماركس نفسه: «الهرم المُتمَفصِل» (Gliederung) – أو كما ترجمهُ ألتوسير: «كاملٌ مُهرَّمٌ عضويٌّ». «في كل أشكال المجتمع»، كتب ماركس، «يمكن لإنتاج محدّد وعلاقاتهِ أن ينيط بكلِّ إنتاجٍ آخر وعلاقاته مكانتهُ وتأثيرها».[60] إنْ مثّل هذا إجازةً هزيلةً لبناء كامل الواجهةِ البنيويّة، فمن الجليّ بالتأكيد – في هذا النص – أنّ ماركس وضع نفسه في معارضةٍ حاسمةٍ مع أيّ فهمٍ قائلٍ بالتماهي البسيط بين مختلف علاقات رأس المال (الإنتاج، التداول، المبادلة، الاستهلاك). وقد تحدّث بإسهابٍ حول تعقيد المحدِّدات بين تلك العلاقات، وإنْ كان مجموع تمفصلاتِها هو ما وفّر له (في هذا النص) موضوعَ بحثه (المبنيّ بنحوٍ نظريّ كما يليق به)، وفي «رأس المال»، وفر له المفتاح لحلِّ الطبيعة المعقدة بالضرورة للعلاقات بين مختلف الدوائر المشتغلة داخل النمط الرأسمالي.[61] وهذا هو العبء الحقيقي لانتقادات ماركس الواسعة في مقدمة 1857 لمعالجة العلاقات المختلفة التي تكوّن النمط الرأسمالي وكأنها «قياسٌ منطقيٌّ منتظمٌ» – «تطابقٌ مباشر». «في اعتبار المجتمع ذاتًا واحدةً أحدًا . . . يعني أنْ يُنظر لهُ نظرةً خاطئةً – تأمليًّا». «الخلاصة التي نبلغها ليس مفادها تماهي الإنتاج والتوزيع والمبادلة والاستهلاك، بل أنّها جميعًا تشكّل أعضاء كليّة تمايزاتٍ في داخل وحدة».[62] بالطريقة نفسها يظهر تحذيرٌ واضحٌ أُصدِر ضد أي مفهومٍ بسيط يقول بالتوالي والتسلسل التطوري للمراحل في هذا التطور: «ما يحدد تسلسلها هي علاقتها ببعضها البعض في مجتمعٍ برجوازيٍّ حديث، وهذا يناقضُ تمامًا ما يبدو كنظامها الطبيعي أو ما يتوافق مع التطور التاريخي. والخلاصة ليست الموقف التاريخي للعلاقات الاقتصادية في تعاقب مُخْتَلف أشكال المجتمع». هذه النقطة الأخيرة تشير إلى ما نودّ تسميته (بالإضافة إلى ما أشير قبلًا) المقدمة الثالثة في طريقة ماركس: المقدمة البنيوية. إن توظيف المقدمة البنيوية، قبل كل شيء، في الأعمال المؤخرة الناضجة لماركس، وطريقة استحواذ ألتوسير والبنيويين عليها وتطويرها، هو ما ينتج – كأحدِ تبعاته النظرية – المفهوم الواسع-المكثف للتمفصل.
المصطلح نفسه إشكاليٌّ بالطبع، فهو هنا يشير إلى مقاربة معينة، دون أن يقدم في داخلة حلًّا نظريًّا للمشكلة التي يشير إليها. وقد تعرّض لنقدٍ مكثف. فالمصطلح نفسه غامضُ المعنى، فهو في الإنجليزية (articulation) يحمل معنى «الربط المفصلي» (كما في أعضاء الجسم، أو كَبُنيةٍ تشريحية) أو «الإفصاح».[63] وفي الاستخدام الألتوسيري المعنى الأول هو المقصود بشكلٍ رئيس. وعلى أي حال، لِفكرةِ أن بنيةً ما «تفصح» عن أخرى اعتراضاتٌ نظرية: فذلك يرقى إلى النظر إلى البنية الثانية كظاهرةٍ ثانوية للأولى (أي: تصوُّرٌ اختزالي) ويتضمن معالجة تشكيلةٍ اجتماعية بصفتها «كُليّة تعبيرية»، أي على وجه التحديد بصفتها موضوع نقدِ ألتوسير الأول للهيغلية. تظل فكرةُ الرابط «التعبيري» – فلنقل: بين البُنيتين الاقتصادية والسياسية لمجتمعٍ ما – حتى في الاستخدام الألتوسيري، ولكنها تُشرح بمصطلحاتٍ أخرى إمّا تكسر أو تقتحم أي لمحةٍ متبقية لـ «توافق» متكاملٍ وضروري. وعليه بالإضافة إلى الإصرار على تمايز كلّ مستوى للمجتمع ولا-اختزاليته و«استقلاليته النسبية»، يداوم ألتوسير على استخدام مصطلحاتٍ مثل «الإزاحة» و«الخَلع» و«التكثف» لإثبات أنّ «الوحدة» التي تشكلها هذه العلاقات المختلفة ليست ذات معنى واحد، بل تغوي عبر «التحديد العلوي» (overdetermination).3في مرادفها الفرنسي (surdétermination) والإنجليزي (overdetermination)، يمكن قراءة المفردة بأنها تعني التحديد العلوي أيضًا، ما قد يحيل إلى مجاز “القاعدة” و”البناء العلوي” (المترجم) ونقدٌ آخر إذن، مفادهُ أن مفهوم «التحديد العلوي» بكل بساطة قد ينتهي بربط شيئين مختلفين برابطٍ هو في الواقع خارجيٌ أو عشوائيٌّ: ما أسماه ماركس يومًا «جارانِ مستقلان . . . لا يدرَكان في وحدتهما».[64] يحاول ألتوسير التغلب على «المجاورة المحضة» هذه بتوظيف مفهوم «التحديد العلوي»، وبمداومةِ الحديث عن «التمفصل» كأمرٍ يتضمن علاقاتٍ تراتبية وتجانبية، أي: علاقاتُ سيادة وتبعية. (نذكر في هذا السياق نقاش ماركس للنقد في مختلف العصور التاريخية، إذ لا «يخوض طريقه عبر كافة العلاقات الاجتماعية»، بل يعرَّف بموجب موقع الدور «السائد» أو «التابع» الذي يؤديه). ولكن هذا يؤدي إلى انتقاداتٍ أخرى. إنّ المخطط المبني حول التمفصل وُصِف، بإنصافٍ في أحيانٍ كثيرة، بأنه ذو «نزعة شكليةٍ» بالغةٍ. وبالتالي، في «السببية البنيوية» التامة لـ «قراءة رأس المال» لألتوسير وباليبار، «الاقتصادي» يحدد «في اللحظة الأخيرة»، إنما ليس بالمحتوى بل أساسًا عبر «تقديم مؤشرٍ للتأثير» للبُنية على مستوى ما أو آخر، أي: بنحوٍ شكلي – رغم تراجع ألتوسير عن بعضٍ من إفراطاته الأشدّ شكليةً.[65] ومع أن كامل محاولة تطوير تحليلٍ كهذا مستندة إلى الحاجة إلى منهجٍ ليس اختزاليًّا، فقد انتقدَت لما أخرجته من مفهومٍ لـ «البنية» هو– لاحتوائه كلّ شروط عمله – بعينه تلك «الكلية التعبيرية» التي يكابد ألتوسير ليتجنبها.[66] والإطار هذا معرّضٌ للنقد القائل إنه يترك العناصر الداخلية لأي «تركيبة بنيوية» ثابتةً مع التغيير، أو أنْ تكون النقلة محدودةً بالتقلّبات (تمفصلاتٌ مختلفة) التي عبرها تتركب «العناصر الثابتة». وهذا يضعف تأريخية المنهج – منافيًا ما أسميناه بالمقدمة التاريخية لعمل ماركس (ومع ذلك، مرةً أخرى، أنظر: ألتوسير 1976). فكرةُ تقلّب العناصر الثابتة هذه أنتجت طريقةً شكليّةً لتعريف «نمط الإنتاج» (نتقفاها خصوصًا عند باليبار)، حتى إنّ بعض التقدمات الفعلية التي حُقِّقت في محاولة إسناد التحليل إلى فهمٍ أكثر تطوّرًا وتقدّمًا لأنماط الإنتاج وتراكبها، يمكن دحضها ببساطة بما يشابه عملية التنقيب الشكلية عن «نمط إنتاج» منفصلٍ ما تلو الآخر. ومع كل ذلك، نود أن نؤكد أن القيمة التوليدية المحتملة للمصطلح ومفاهيمه الشقيقة، التي أعطتنا منطلقًا للتفكير بالكلّية المعقدة وحدود مِيَز التشكيلات الاجتماعية، دون الوقوع في الاختزالية «المادية الفجة» أو الساذجة من جهة، أو شكلٍ من أشكال التعددية السوسيولوجية من جهةٍ أخرى.
اقتصر حديثي حتى الآن حول تطبيق مصطلح «التمفصل» على البنية الاقتصادية لتشكيلات اجتماعية معقدة. ولكنّي قلت أيضًا إن التشكيلة الاجتماعية يمكن تحديدها هي الأخرى كـ «هرمٍ متمفصل». فعلى المستوى الاقتصادي قد يتضمن هذا تمفصلَ بنيةٍ اجتماعية حول أكثر من نمطِ إنتاجٍ واحد. وبعض السمات السياسية والأيديولوجية لهكذا مجتمعات يمكن تفسيرها إذن بالرجوع إلى هذه التركيبة المحددة. ولكن من الممكن أيضًا أنْ نقدم تصويرًا للمستويات المختلفة لتشكيلةٍ اجتماعية، كهرم متمفصل. ومنذ أن علينا افتراض عدم وجود «تناظر ضروري» – لا استنساخ كامل، أو ندّية للبنى، أو صلةٍ تعبيرية – بين هذه المستويات المختلفة، إنما مع إلزامنا بأن «نفكر» في العلاقات بينها بصفتها «فرقة من العلاقات» (متصفة بما أسماه ماركس في مقدمة 1857، في صدد معالجته هذه القضايا، وعرفه بـ «قانون التطور غير المتكافئ»)، علينا إذن أن نعيد أنظارنا إلى طبيعة التمفصلات بينها. الاهتمام – من نوع أكثر تفصيلًا وتحليلًا – بطبيعة أنماط الإنتاج، يساعدنا على إسناد هذه الجوانب الأخرى للتشكيلة الاجتماعية بنحوٍ ألْيَق إلى مستوى البنى الاقتصادية (المقدمة الاقتصادية). ولكن لا يمكننا بالتالي أن نستنتج بداهة علاقات البنى السياسية والأيديولوجية وآلياتها (حيثُ تعاود سماتٌ كالعنصرية الظهور قطعًا) حصريًّا من المستوى الاقتصادي. فالمستوى الاقتصادي هو الشرط الضروري ولكن غير الوافي لشرح العمليات على مستوياتٍ أخرى للمجتمع (مقدمة اللا-اختزالية). فلا يمكننا إذن افتراضُ علاقةٍ تعبيرية ذات «تناظر ضروري» بينها (مقدمة الميزة التاريخية).
وهذه، حسب ماركس، «منتوج علاقات تاريخية وجوازها بأكمله محصورٌ بتلك العلاقات ولأجلها». وهذا توضيحٌ مهمٌّ، بل وحيويٌّ. فهو يلزمنا بإثبات طبيعة «التناظر» ودرجته، بدل افتراض بداهته، في أي حالة تاريخية معينة. وبالتالي، عبر هذا المنفذ، تبدأ معالجة بعض الانتقادات سالفة الذكر من منظور التفسيرات «السوسيولوجية» – مثل لزوم التمييز التاريخي – من داخل إطار هذه المراجعة المفتاحية.
ولكن لنا هنا أن نعرف عددًا من المواقف المختلفة داخل الإشكالية العامة لـ «التمفصل». فقد ذهب بعض المنظِّرِين إلى أنّ كل ما يمكننا فعله هو التعامل مع كل مستوى، بموجب تمايزه الخاص، و«شروط وجوده» الواجب إيفاؤها لكي يشتغل (مثلًا: العلاقات الاقتصادية للنمط الرأسمالي تستلزم، كشرطٍ لوجودها، أطرًا تشريعية لا-اقتصادية، تؤمِّن «العقد» بين مشتري قوة العمل وبائعها). ولكن – كما قيل – لا يمكن للمستوى الاقتصادي أن يحدد مسبقًا أو يعرّف الأشكال والمِيَز الداخلية للمستويات اللا-اقتصادية التي «يستلزمها»، وكأنها ضرورةٌ رسميّةٌ لاشتغاله. وهذا بمثابة نظريةٍ لـ «الاستقلالية» (وليس «الاستقلالية النسبية») لمختلف المستويات.[67] ولكن هذا يخفق في معالجة التشكيلات الاجتماعية كـ «وحدةٍ معقدة»: ما وصفه ماركس بـ «وِحدةٍ بعدة مُحدِّدات».
تُدْرك مُقارباتٌ أخرى احتمال وجود «تركيباتٍ اسْتِماليّة» (tendential combinations): تركيباتٌ وإنْ لم تكُن محددة مسبقًا بالمعنى الجبري الكامل، فهي تركيباتٌ «مفضلة»، رسَّبها وصلَّبها التطور التاريخي الحقيقي مع مرور الزمن. وبالتالي كما يتضح من تجربة أمريكا اللاتينية، لا «تصاحب ضروري» بينَ تطورِ شكلٍ من أشكال الرأسمالية والأشكال السياسية للديمقراطية البرلمانية، فللرأسمالية أن تنشأ على قواعدَ سياسية شديدة الاختلاف. وإنجلز نفسه بيّنَ كيف تقدر الرأسمالية على تسخير نُظمٍ قانونية شديدة الاختلاف وتكيّفها لخدمة وظائفها. وهذا لا يمنعنا من القول بكثرة (ميل) تصاحبِ طلوع الرأسمالية مع تشكيل أنظمة ديمقراطية برلمانية برجوازية، أو حتى من قبول ملاحظةِ لينين المتبصّرة بأن الديمقراطية البرلمانية توفر «أفضل ما يمكن» من «غلاف سياسي للرأسمالية». ولكنْ علينا أن نرى هذه «التركيبات» بصفتها مميزة تاريخيًّا، لا محددة قبليًّا: بصفتها «قوانين ميل» – يمكن أن تبطلها «ميولٌ مضادة». لنأخذ مثالًا وثيق الصلة الآن: في أوروبا، طلوع الرأسمالية جاء على تدمير الروابط الإقطاعية وتشكيل «العمالة الحرة» – تشكيل قوّةِ العمل كسلعة. ومن الصعب التفكير بتشكيلةٍ رأسمالية حيث لا يتوفر شكلٌ من أشكال قوة العمل لرأس المال بشكلِها «الحر». وهذا بدوره يعني أنّه مهما كان الإطار القانوني الذي «يتصاحب» معه التطور الرأسمالي، من الواجب أن يظهر فيه مفهوم «العقد» الشرعي بين «أشخاصٍ أحرار»، لينظِّمَ قانونيًّا أشكالَ التعاقد الذي تستلزمه «العمالة الحرة». وهذا «اللزوم» أكثرُ من محض «شرط وجود» فارغٍ أو شكليٍّ. ولكنّ هذا لا يعني أنّ الميل إلى تركّب الرأسمالية مع «العمالة الحرة» لا يمكن، تحت شروطٍ تاريخية، أن يقطعه أو يبطله ميلٌ مضادٌّ، تحديدًا: إمكانية تأمين شروطٍ معيّنة لوجود الرأسمالية بنحوٍ ناجع عبر تركيب «العمالة الحرة» بأشكال معينة للعمالة «غير الحرة» أو «الإكراهية». فكلما نبتعد عن المجتمعات الأوروبية، وإلى مجتمعات ما بعد الغزو وما بعد الاستعمار – العمل الحر و«غير الحر»، على أساسِ تركيب أنماطٍ مختلفة للإنتاج – تصبح هذه هي الحالة النموذجية. ولكن هذا يترك تقريبًا كل شيءٍ مهمٍّ من الواجب فعله من أجل تطوير فهمٍ أفضل لـ «قوانين الحركة» للتشكيلاتِ الرأسمالية، مبنيًّا بهذا النحو البديل. ومن الطبيعي إذن أنّ لذلك آثارًا على البنى السياسية والقانونية. ففي هذه التشكيلات الاجتماعية «المنحرفة» (منحرفة فقط بمعنى ابتعادها عن الحالة النموذجية الأوروبية) ستوجد بنىً سياسية تركّب (أو قد تركّب) أشكالًا للديمقراطية البرلمانية مع أشكالٍ أخرى للتمثيلِ السياسي – أو بنىً قانونية ذات تفصيلٍ أوسع من شكلٍ واحدٍ لحالةِ المواطنة. إنّ «تمفصلَ» عمالةٍ «حرة» و«إكراهية»، وتركيبُ حقوقٍ شرعية «متساوية» بأخرى «مقيدة»، وَوضعيةُ الزعماء في «المستعمرات الداخلية» البانتوستانية، والأوضاع القانونية المختلفة للمواطنين «البِيْض» و«السود»، في التشكيلة الاجتماعية الجنوب أفريقية، تمثِّل بنحوٍ مُتقَن عناصرَ إحدى الحالات «المتحوّرة» هذه – حالةٌ ليستِ بأي حالٍ من الأحوال «لا-رأسمالية»؛ شريطةَ أن نقرأ «قوانين التطور والحركة» التي وضعها ماركس كقوانين ميلٍ (وميلٍ مضاد) بدلًا من قوانينَ إلزامية قَبْليّة.
وفيما يتعلق، إذن، بالعلاقات بين المستويات المختلفة للتشكيلة الاجتماعية، إنّ المرء بحاجة لمفاهيم إضافية – أي: لتوفير تحديداتٍ إضافية – على تلكِ المعبأة لأجل تحليلِ مستويات «نمط الإنتاج» الاقتصادية. ويحتاج المرء للإقرار بأن المستوى الاقتصادي، وحدهُ، عاجزٌ عن التحديد المسبق لما ستكونه تلك المستويات وكيف ستشتغل – حتى لو تعذر تمييز آلياتها دون احتساب مستوى الاقتصادي. وهنا يجب مكاملة عملِ ألتوسير، والآلتوسيريين – مثل عمل بولانتزاس عن الدولة – بعمل منظِّرٍ ماركسيٍّ آخر شَرْحُه، على هذا المستوى، يشكل مشاركةً في تنميةِ ماركسيّةٍ ذات أهميةٍ قصوى وصارمةٍ في رفضها الاختزالية. وهذا العمل هو عمل غرامشي. إنّ عمل غرامشي يتصف بالتشظّي (فجزءٌ كبيرٌ منه كتب في السجن، تحت عين الرقيب، في أحد سجون موسليني)، وأقلُّ «تنظيرًا» من ألتوسير. وكان لغرامشي مكانةٌ في تكوين إشكالية ألتوسير، إنما، لأنّ جوانبَ من غرامشي ظلَّتْ «تاريخانية»، فالعلاقةُ بين ألتوسير وغرامشي علاقةٌ معقدة. وفي مراجعةٍ نشرت مؤخرًا لهذه العلاقة، وصفناها بالقول إنّ غرامشي يوفر حالةً استثنائية للتاريخانية بالنسبة للبنيوية الماركسية.[68]
لا يمكننا التفصيلُ في مفاهيم غرامشي بأي عمقٍ هنا.[69] المفهوم المركزي في عمله هو مفهوم الهيمنة. والهيمنة هي تلك الحالة ذات «السلطة الاجتماعية الشاملة» حيث، عند ظروفٍ مميزة محددة، ينتصرُ تحالفٌ طبقيٌّ مميزٌ، بتركيبةٍ من «القسر» و«الرضى»، على كافة التشكيلة الاجتماعية، إنما تحديدًا على مستوى القيادة السياسية والأيدولوجية، في الحياة المدنية، والفكرية، والأخلاقية، وكذلك على المستوى المادي؛ وعلى تضاريس المجتمع المدني مثلما في العلاقاتِ المكثَّفة للدولة وخلالها. هذه «السلطة والقيادة»، بالنسبة لغرامشي، ليست معطاةً قَبْليًّا، بل هي «لحظةٌ» تاريخية مميزة – لحظةُ سلطةٍ اجتماعية غير اعتيادية. وهي تمثل منتجَ إتقانٍ معيّنٍ للصراع الطبقي بلا شك، لكنها تظل خاضعةً للصراع الطبقي و«علاقات القوى الاجتماعية» في المجتمع المعني، حيث «توازنها غير المستقر» ليس إلّا نتيجةً أو حصيلةً واحدةً ومؤقّتةً ومشروطةً، من عدةِ احتمالاتٍ أخرى ممكنة. الهيمنة هي حالةُ لعبٍ في الصراع الطبقي يجب، بالتالي، العمل عليها وإعادةُ بنائها باستمرار لكي تُصانَ، وتظلُّ ظرفًا تناقضيًّا. النقطة المهمة، بالنسبة لغرامشي، هي أنّه في ظل شروطٍ هيمنية، إنّ تنظيم الرضى (من الطبقاتِ المسيطرة إلى «قيادة» التحالف الطبقي المسيطر) يستبق (ولا يلغي) ممارسة السيطرة عبر القسر. في مثل هذه الشروط، يميل الصراع الطبقي لأخذِ شكلٍ، ليس شكل «الهجمة الأمامية» على معاقل الدولة («حرب المناورة»)، بل صراعًا أطولَ، واستراتيجيًّا وتكتيكيًّا، يستغل ويعمل على عددٍ من التناقضاتِ المختلفة (ما يسميه غرامشي «حرب المواقع»). وحالةُ الهيمنة تمكّن التحالف الطبقي الحاكم من الشروع بتلك المهمة المهولة، مهمةُ تغيير «البنية العليا» للمجتمع، وتسخيرها، وتأمينها، وشرحها، بما يتوافق والمستلزمات الطويلة الأمد لتطوير نمط الإنتاج – أي: مراكمة رأس المال على مقياسٍ أوسع. وهي تمكّنُ تحالفًا طبقيًّا كهذا من الشروع بالمهام التعليمية والتكوينية للرقيّ بالتشكيلة الاجتماعية الكاملة إلى ما يسمّيه «مستوىً جديدًا للحضارة»، يميل إلى النظام المتّسع لرأس المال. وهذا لا يعني الفرضَ الفوري والمباشر للمصالح الطبقية «الفئوية» الضيقة وقصيرة الأمد لطبقةٍ واحدةٍ على مجتمع ما. بل هي تصوغ تلك الوحدة بين الأهداف الاقتصادية والسياسية والاقتصادية بنحوٍ يضع «كافة الأسئلة التي يخاض حولها الصراع على مستوىً «كونيٍّ»، لا مستوى فِئويٍّ، وبالتالي يخلق هيمنةً لمجموعةٍ اجتماعيةٍ أساسيّةٍ على سلسلةٍ من المجموعاتِ التابعة». وهذا هو ما يسمّيه غرامشي «الدور التعليمي والتكويني للدولة. . . . هدفهُ دائمًا هو خلقُ أنواعٍ جديدةٍ وأعلى للحضارة، وتكييف «حضارة» وأخلاقيات الجماهير الشعبية الأوسع لضرورات التطوير المستمر للجهاز الاقتصادي للإنتاج» – تشكيل «الإرادة الوطنية-الشعبية»، استنادًا إلى علاقةٍ محددة بين الطبقاتِ المُسيطِرَة والمسيطَر عليها. وهذا إذن لا يعتمد على تصاحبٍ مفترضٍ أو ضروريٍّ أو قبليٍّ بين البنية (الاقتصادية) والبنى العلوية (السياسية والأيديولوجية)، بل تحديدًا على تلك الآليات المميزة تاريخيًّا – والتحليل الملموس لتلك «اللحظات» التاريخية – التي عبرها تُصاغ علاقةٌ معيارية بين البنية والبنى العلوية. بالنسبة لغرامشي، هدف التحليل هو دائمًا ميزةُ مجمّع «البنية-البنية العلوية» هذا – إنما بصفته تمفصلًا ملموسًا تاريخيًّا. «إنها مشكلة العلاقات بين البنية والبنية العلوية التي من الواجب طرحها وحلّها إنْ أريد تحليل القوى الفاعلة في التاريخ تحليلًا صائبًا…». وهذا التصوير المفاهيمي تصويرٌ لا-اختزاليٌّ صارمٌ: «كيفَ لنا إذن أن نفهم النظام الكامل للبنى الفوقية بصفته تمايزاتٍ داخل السياسة، وبالتالي، كيف نبرر إدخال مفهوم التمييز في فلسفة الممارسة؟ لكن هل للمرء أن يتكلم حقًّا بجدلية المتمايزات، وكيف لنا أن نفهم مفهوم الدائرة التي توصل مستويات البنى الفوقية؟ مفهوم «الكتلة التاريخية»، أي . . . وحدة المتضاداتِ والمتمايزات؟ هل للمرء أن يدخل معيار التمايز في البنية أيضًا؟». من الجلي أن غرامشي يجيب على هذه الأسئلة بالإيجاب. وهو بالخصوص حادٌّ ضدّ أي شكلٍ من أشكال الاقتصادوية الفظة: «من الضروري إذن محاربةُ الاقتصادوية ليس فقط في نظرية التأريخ، بل أيضًا وخصوصًا في نظرية السياسة وممارستها. وفي هذا الحقل، يمكن للنضال بل، ويجب أن يُحمَل بتطوير مفهوم الهيمنة».[70]
لم يبتدئ تقدير مساهمة غرامشي النظرية إلّا مؤخرًا، رغم الإقرار القديم بدورهِ كمناضلٍ لامعٍ في السياسة الإيطالية في العشرينيات والثلاثينيات. ولتحليله أثرٌ، أثرٌ ثريٌّ ومُثمِر، على تحليل التشكيلات الاجتماعية البرجوازية الكبرى من النوع الرأسمالي المتقدم في أوروبا – أوروبا الغربية، حيثُ من الجلي أنّ تحليلًا اقتصادويًّا اختزاليًّا لن يكفي لتفسير عمقُ التحولات المتضمنة. ولربما لهذا السبب نفسه نُظِرَ إليه، بالدرجة الأولى، كمنظِّرٍ ماركسيٍّ لـ «الرأسمالية الغربية». ولهذا فعمله بالكادِ طُبِّقَ أو وُظِّفَ في تحليلٍ التشكيلات غير الأوروبية. ولكن للقول بأن لأعماله صلةٌ خاصةٌ بالتشكيلات الاجتماعية غير الأوروبيةِ أساسٌ قويٌّ جدًّا، لثلاثة أسبابٍ منفصلة. أولًا: قد يُعِين غرامشي في تحييد الوزن الغالِب للاقتصادوية (الماركسية وغير الماركسية) التي انطبعت على تحليلِ مجتمعاتِ ما-بعد الغزو الأوروبي والمجتمعات «الاستعمارية». ولعله بسبب الوضوح القوي لِوَزن العلاقات الاقتصادية الإمبريالية، ساد فهمٌ لهذه التشكيلات بأنها قابلةٌ للشرح عبر تطبيقٍ لـ «الإمبريالية» بصفتها عمليةً «اقتصادية» خالصة. ثانيًا: تقدّم هذه المجتمعات مشاكلَ بالنسبة إلى العلاقة في «مجمّع البنية-البنية العليا» تعادل في تعقيدها تعقيد تلك التي كَتب عنها غرامشي. وبالطبع لا يُنْصح بالنقل البسيط للمفاهيم هنا، فغرامشي سيكون أولَ من يصرُّ على الميزة التاريخية، على الاختلاف. وثالثًا: رأى غرامشي مشكلة «الهيمنة» من داخل التاريخ المميز للتشكيلة الاجتماعية الإيطالية. وهذا أعطاه منظورًا محددًا وذو صلةٍ وثيقةٍ جدًّا بالمشكلة. فَلِفتراتٍ طويلة اتصفت إيطاليا على وجه التحديد بغياب «الهيمنة»: بتحالفِ طبقاتٍ حاكمة تحكم عبر السيطرة، بدلًا من أن تحكم عبر قيادة (توجيه) الطبقة المهيمِنة. ولهذا فعلمهُ ذو أهميةٍ مماثلةٍ للمجتمعاتِ حيث، وفقَ إيقاعِ النضال الطبقي وعلاماتِ ترقيمه، وقعت تَحرّكاتٌ معتبرة نحو الدخول إلى مرحلةٍ ذات «توجيهٍ مهيمِن» وللخروج منها. وأضف على ذلك أنّ إيطاليا كانت وما تزال مجتمعًا ينطبع عليه قانون التطور اللا-متكافئ انطباعًا قاسيًا: بتطوّرٍ صناعيٍّ رأسماليٍّ مهولٍ في الشمال، وتخلّفٍ مهولٍ في الجنوب. وهذا يبعث بمسألة كيفية تمفصل تناقضات التشكيلة الاجتماعية الإيطالية عبر أنماط إنتاج (رأسمالية وإقطاعية) مختلفة، وعبر تحالفاتٍ طبقيةٍ تركّب عناصر من أنظمة اجتماعية مختلفة. ومشكلة الدولة، ومسألة التحالفات الطبقية بين البروليتاريا الصناعية وطبقة الفلاحين، و«مباراة» الأيديولوجيات التقليدية والمتقدمة، والصعوبات التي تطرحها هذه في تشكيل «إرادة وطنية-شعبية»، كلّها تجعل تحليله ذو أهمية خصوصًا للمجتمعات الاستعمارية.
دخل عمل غرامشي مؤخرًا طور التناول والتطوير بنحوٍ بُنيويٍّ – خصوصًا في مقال ألتوسير حول «الأجهزة الأيديولوجية للدولة».[71] وهذا المقال المبتكر يختلف عن عمل غرامشي، تحديدًا، في طرحه المشكلة بمفرداتِ «إعادة الإنتاج». ولكن الشواغل التي تتخلل هذه المقاربة ليست بعيدةً ذاك البعد من شواغل غرامشي. من اللازم لعلاقاتِ الإنتاج الاقتصادية أن «يُعاد إنتاجها». وإعادة الإنتاج هذه ليست اقتصاديةً فحسب، بل اجتماعيةٌ، تقنيةٌ، وعلاوةً على كل شيء: أيديولوجية. وهذه طريقةٌ أخرى لصوغ ملاحظةِ غرامشي القائلة بأن العلاقات الاجتماعية الرأسمالية تستلزم – في سبيل تحقيق تطوّرها الكامل – أنْ تُربَط بتطوّرٍ مشروحٍ، وانشراحٍ على المستويات «غير الاقتصادية» للسياسة، والمجتمع المدني، والثقافة، عبر القيادة الأخلاقية، والفكرية، والأيديولوجية. وألتوسير يتشارك إذن الشاغل الكلاسيكي لغرامشي حول طريقةِ تأمينِ «هيمنة» تحالفٍ طبقيٍّ حاكمٍ، على المستويات الأخرى، عبر قيادةٍ أو سلطةٍ طبقيةٍ تعليميةٍ وتأسيسيةٍ على التشكيلة الاجتماعية ككل. وكلاهما يذهبانِ إلى أنّ هذه الهيمنة الموسّعة أو الممتدة خاصّةٌ بمؤسساتِ، وأجهزةِ، وعلاقاتِ ما يدعى «البنى العلوية» للدولة والمجتمع المدني. وكلٌّ من ألتوسير وغرامشي، إذن، يُشددان على أنّ للأيديولوجيا – رغم كونها موقعًا تُناقضيًّا ومُرْتَهنًا في الصراع الطبقي – وظيفةٌ محددةٌ في تأمين الشروط لإعادة الإنتاج الممتدة لرأس المال. فهي بالتالي مستوى مهمٌّ ومتمايزٌ للصراع، حيث تؤمّن القيادة ويُتنازَع عليها، بآلياتٍ ومواقعَ للصراع «مستقلة نسبيًّا». وكلاهما يؤكدان أيضًا أنّ «الأيديولوجيا» ليست مجرّدَ شكلٍ من أشكال الوعي الزائف؛ تقبل التفسير كمجموعةٍ من الأساطير أو كمجرّد أبنيةٍ عقلية زائفة. كلّ المجتمعات تستلزم أيديولوجيات مميزةٍ، توفّرُ أنظمةَ المعنى، والمفاهيم، والأصناف، والتمثيلات التي بها يُدرَك العالم، ومن خلالها «يعيش» البشر – وإنْ دونَ وعيٍ، ومن خلال سلسلةٍ من «سوء الإدراك» – بطريقةٍ تخيّلية، علاقتَهم بالشروط المادية الحقيقية لوجودهم (حيث لا يمكن أن تتمثل لهم إلّا كأنماط وعي، في وعبر الأيديولوجيا). يميل ألتوسير أحيانًا إلى تمثيل الأيديولوجيا بأنها مرتبطةٌ ارتباطًا مُحكمًا مُبالغَ الوظيفية بِحُكمِ الطبقاتِ المسيطرة، وكأنما كلُّ الأيديولوجيا، بموجب التعريف، تشتغل ضمن أفق «الأفكار المسيطرة» للطبقة الحاكمة. أما غرامشي فيفكّر بالأيديولوجيات بطريقةٍ أكثر تناقضيّةٍ – بصفتها مواقعَ ومُرْتَهَناتٍ في النضال الطبقي. ما يهمّ غرامشي هو: كيف للأيديولوجيات الموجودة – «الحسّ العام» للطبقات الأساسية – التي هي بعينها النتيجةُ المعقّدة للحظاتٍ ومحصلاتٍ في الصراع الطبقي الأيديولوجي، أنْ تُجبَل بنحوٍ نشطٍ لتحويلها إلى أساس صراعٍ أكثر وعيًا، وتشكيلِ مداخلةٍ في السيرورة التاريخية. ولكن كلاهما يؤكدان أنّ الأيديولوجيات ليست أمرًا «ذهنيًّا» فحسب، بل هي علاقاتٌ ماديةٌ – ما سمّاه لينين «علاقات اجتماعية أيديولوجية» – تشكل الأفعال الاجتماعية، وتشتغل عبر مؤسساتٍ وأجهزةٍ عينيّة، وتتجسَّد عبر الممارسات. وغرامشي يصرّ على السيرورة التي تحوِّل هذه «الأيديولوجيات العملية» الكبرى للطبقات الاجتماعية الأساسية. وأما ألتوسير فيضيفُ أنّ الأيديولوجيات تشتغل عبر تكوين الأفراد العينيّين بصفتهم «ذواتًا اجتماعية» للخطاباتِ الأيديولوجية – سيرورةُ ما سمّاه «مناداة الذوات».
هذه المقدمات تقدم بها مؤخرًا لالكلاو بمداخلةٍ ابتكارية .[72] في مقالاته حول «الشعبوية» و«الفاشية»، يذهبُ لاكلاو إلى أنّ العناصر الفردية لهذه الأيديولوجيات (مثل: القومية، النزعة العسكرية، العنصرية، «الشعب»، إلخ) لا تحمل، بحدِّ ذاتها، انتماءً طبقيًّا ضروريًّا، «لا مضمون طبقي ضروري». لا يمكننا الافتراض، قبلًا، أنّ هذه العناصر «تنتمي» بالضرورة إلى أيِّ طبقةٍ مميزة، بل ولا يمكننا افتراضُ طبقةً ما، بصفتها كيانًا فردًا متجانسًا، تحملُ «منظورًا عالميًّا» واحدًا موحّدًا غير متناقض، تحملهُ معها، حسب تعبير بولانتزاس، على مر التاريخ، «وكأنه لوحةُ أرقامٍ مثبّتة على مؤخرتها».[73] تُظهِر الأيديولوجيات، بصفتها تشكيلاتٍ خطابيّة عينية، «وِحدةً» غريبةً خاصّة بها. وهذه الوحدةُ تنشأ، أولًا، مما يسميه لاكلاو «التكثيف»: حيثُ كلِّ عنصرٍ «يلبّي دور تكثيفٍ للأخريات. حينما المناداة العائلية، مثلًا، تُوقظ مناداةً سياسيةً، أو مناداةً جمالية، أو حينما كلٌّ من هذه النداءات المنعزلة تشتغل كرمزٍ للأخريات، يكون لدينا خطابٌ أيديولوجيٌّ موحدٌ نسبيًّا». (وقد عُرِّفَ هذا بصفته «وحدة أيديولوجية» عبر سيرورة تكثيفٍ مضاميني).[74] ثانيًا، تؤمَّن الوحدة عبر «المناداة المميزة التي تشكل محور كامل الأيديولوجية ومبدأها المُنظِّم. ففي محاولةِ تحليل المستوى الأيديولوجي لتشكيلةٍ اجتماعيةٍ محددة، يجب أن تكون مهمتنا الأولى هي إعادة بناء البنى الندائية التي تكوِّنها»
. وإنْ لم يكن للعناصر الأيديولوجية المنفصلة انتماءٌ طبقيٌّ ضروريٌّ، وليس للطبقاتِ أيديولوجيّاتٌ نموذجيّةٌ معهودة بها أو محفورةٌ فيها، ما العلاقةُ إذن بين الطبقات والأيديولوجيات؟ كما قد يُفترَض، تُفهَم هذه العلاقة بمفرداتِ طريقة مَفْصَلةِ الصراع الطبقي للخطابات الأيديولوجية المتنوعة. «التمفصل يستلزم . . . وجودَ محتوياتٍ لا-طبقية (نداءات وتناقضات) تشكل المواد الخام التي تشتغل عليها الممارسات الأيديولوجية الطبقية. إنّ أيديولوجية الطبقة المسيطرة، لأنها مسيطرةٌ، لا تنادي أعضاء تلك الطبقةِ فقط، بل حتى أعضاء الطبقة المسيطر عليها». يُقاس نجاحها بمفصلتها «الأيديولوجيات المختلفة بمشروعها المهيمن عبر إلغاءِ السمة الخِصامية (لتك الأيديولوجيات)». تُحوَّل الأيديولوجياتُ إذن «عبر الصراع الطبقي، الأمر الذي يُنفَّذ عبر إنتاج الأفراد ومَفْصَلة الخطابات وفكِّ تمفصلها». وهذا يتبع غرامشي الذي ذهب إلى أنّ الأيديولوجيات لا يمكن اختزالها في «المصالح الطبقية» المرئية والمتسقة لذواتها الطبقية، وأنّ الأيديولوجيات تُحوَّل، لا بأنْ تَفْرض طبقةٌ ما «منظورها العالمي» الموحّد على كل الطبقات الأخرى، بل عبر «سيرورة تمايزٍ وتغيّرٍ في الوزن النسبيّ الذي تملكه عناصرُ الأيديولوجية القديمة . . . فما كانَ ثانويًّا أو تابعًا أو حتّى عَرَضيًّا يغدو ذو أهميةٍ رئيسة، يغدو نواةَ فرقةٍ عَقَديةٍ أو أيديولوجية جديدة».[75] (أنظر أيضًا: موف لأجل شرحٍ مهمٍّ لهذه المقولة فيما يتعلق بغرامشي). في صيغ لاكلاو الأولية مشاكل: مثلًا، ما هذه «الممارسات الطبقية» الممكن أنْ تشتغل على تحويل الأيديولوجيات، ولكنها بحدّ ذاتها، حسبَ الفرض، خاليةٌ من أي عناصر أيديولوجية مميزة «تنتمي» إليها؟ رغم هذه الصعوبات، يبدأ هؤلاء المنظِّرُون بتوفير عناصر أولية لنا، يمكننا بواسطتها محاولة بناء نظريةٍ لا-اختزالية للجوانب اللا-اقتصادية للتشكيلات الاجتماعية أو الجوانب المعنية بالبنية العلوية – وَوقود ذلك، مرةً أخرى، هو استخدام مفهوم التَمَفصل.
ما حاولتُ فعله في هذه الورقة هو توثيق نشأة نموذجٍ نظريٍّ جديدٍ، يأخذ وجهته الأساسية من إشكالية ماركس، ولكنه يسعى، بوسائلَ نظريّةٍ متنوعة، تجاوز بعض الأغلال – الاقتصادوية، الاختزالية، «القَبْليّة»، فْقرُ التمييز التاريخي – التي قيّدت بعض الاستخداماتِ التقليدية للماركسية، والتي ما تزال تشوّه المساهمات في هذا الحقل من كُتّابٍ مميزين في نواحٍ أخرى، ما يتركُ الماركسية ضعيفةً في وجه انتقاداتٍ فعّالة مِن قِبل التيارات العديدة المختلفة، سواءً الأحادية الاقتصادية أو التعددية السوسيولوجية. وهذا مسحٌ لحقلٍ ناشئ، وليس تقريرًا نقديًّا مستفيضًا. ويجب ألا يفترض أبدًا أنّ الحلول المشروع بها بُيِّنَت تمامًا، أو أنّها، حتى الآن، مطورّةٌ تطويرًا وافيًا أو دونما نقاط ضعفٍ وفجواتٍ معتبرة. ففيما يتعلق بتلك التشكيلات الاجتماعية ذات البناء العرقي، التي تشكل موضوع البحث الرئيس لهذه المجموعة، فلإشكاليةُ بالكادِ طُبِّقَت. وعليه كل ما كان بوسعي هو الإشارة إلى بعض نقاط الانطلاق الاستراتيجية المعينة في حقلٍ محتملٍ للتطبيق، بعضِ البروتكولات للعملية النظرية. وتحديدًا، لا توجد نظريّةٌ وافيةٌ للعنصرية بَعْد تملك القدرة على معالجةِ السِمات الاقتصادية والسِمات المعنية بالبنية العلوية لهذه المجتمعات، وقادرةٌ بتزامنٍ على توفير تفسيرٍ محسوسٍ تاريخيًّا ومميزٍ اجتماعيًّا للأوجه المتميزة عرقيًّا. مثل هذا التفسير الوافي، لاستبدال تلك النسخ غير الوافية السائدة على الحقل، لم يقدّم بعد. ومع ذلك، وفي سبيل رعايةِ تطوّرٍ كهذا والترويج له، فلعله من النافع أنْ نختتم بخطوطٍ عريضةٍ موجزة لبعض البروتوكولات النظرية – وهي في رأيي أمرٌ ضروريٌّ – يجب أنْ تحكم أيَّ تحقيقٍ مقترحٍ بهذا الشأن.
يجب أنْ تبدأ هذه من تطبيقٍ صارمٍ لما أسميته مقدّمة التمييز التاريخي. العنصرية لا تُعالَج كسمةٍ عامةٍ للمجتمعات الإنسانية، بل كعنصريّاتٍ متمايزةٍ تاريخيًّا. ابتداءً من افتراض الاختلاف، والتمايز، بدلًا من «البُنية» الكونية الوحدوية العابرة للتاريخ. وهذا دون إنكار أنّه قد تُكتَشف بعض السمات المعينة المشتركة لكل تلك الأنظمة الاجتماعية التي قد يرغب المرء نسبَ لقب «ذات بناءٍ عرقيّ» إليها. ولكن – كما أشار ماركس حول الطبيعة «الفوضوية» لكافة التجريدات التي تنطلق من مستوى «عمومًا» حصرًا – هكذا نظريةٌ في العنصرية ليست المصدر المفضّل للتطوير والبحث النظريين: «رغمْ أنّ أكثر اللغات تطوّرًا تملك قوانينًا وسماتٍ مشتركةٍ مع تلك الأقل تطوّرًا، مع ذلك، ما يحدد تطوّرها هو تلك الأشياء، أي: العناصر غير العامة وغير المشتركة، يجب فرزها وفصلها . . . حتى في وحدتهما . . . لا ينسى اختلافها الجوهري.[76] العنصرية عمومًا هي «تجريدٌ عقلانيٌّ» بقدر ما هي «تَستخرج حقًّا وتثبّت العامل المشترك وتكفينا عناء التكرار». وبالتالي قد تساعدنا في تمييز تلك السمات الاجتماعية التي تثبّت المواقع المختلفة للمجموعات الاجتماعية والطبقات على أساسِ النسب العرقي (المعرَّف بيولوجيًّا أو اجتماعيًّا) من الأنظمة الأخرى ذات الوظائف الاجتماعية المشابهة. ولكنْ، «بعضُ المحددات تنتمي لكافة الحُقَب، وبعضها الأخر ينتمي لقلّة منها. بعضها ستتشاركها أحدثُ الحُقبِ وأقدمها». وهذا تحذيرٌ ضدّ استنباطِ بنيةٍ مشتركةٍ وكونيّةٍ للعنصرية، تظل مثلما هي جوهريًّا، خارجَ موقعها المميز تاريخيًّا. فقط مع التمييز التاريخي للعنصريات المختلفة – في اختلافها – يمكن فهمها فهمًا لائقًا بصفتها «نتاج علاقاتٍ وسيروراتٍ تاريخية وتملك. . . جوازيّةً كاملةً فقط بتلك العلاقات وداخلها». ويتبع من ذلك أن ما قد يُتعلَّم من تمييز أفضل لما قد يبدو، في الحسّ العام، كسلالاتٍ للشيء نفسه، فمثلًا: تمييزُ العنصرية في الجنوب الأمريكي الاستعبادي من عنصرية إدخال السود في «الأشكال الحرة» للتطور الرأسمالي الصناعي للشمال الأمريكي ما بعد الحرب الأهلية، أو تمييز عنصرية المجتمعات الاستعبادية الكاريبية من عنصرية مجتمعاتِ المراكز الاستعمارية مثل بريطانيا، التي كان عليها استيعاب العمّال السود في الإنتاج الصناعي في القرن العشرين.
جزئيًّا، لا بد من ذلك لأن المرء لا يمكن أن يفسر العنصرية بتجريدٍ من العلاقات الاجتماعية الأخرى – وحتى لو، بدلًا من ذلك، لا يمكن تفسيرها باختزالها في تلك العلاقات. سبق وقيل إنّ في التشكيلات الاجتماعية السابقة للرأسمالية عنصريّاتٌ مزدهرة. وهذا يعني فقط أنّه عند معالجة تشكيلاتٍ اجتماعيةٍ أحدث يلزم على المرء تبيان كيف أعيد تنظيمُ العنصرية وأعيدت مفصلتها بنحوٍ كلّيٍ مع علاقاتِ أنماط الإنتاج الجديدة. فللعنصرية داخل مجتمعات العبودية في المرحلة المركنتالية للتطور الرأسمالي العالمي مكانةٌ ووظيفةٌ، ووسائل وآلياتٌ لفعاليتها المميزة، لا يمكن لتفسيرها بترجمتها من تلك السياقات المميزة تاريخيًّا إلى سياقاتٍ مختلفة كلّيًّا إلا أنْ يكون تفسيرًا سطحيًّا.[77] وذهبَ آخرون إلى أنّ العبودية في العصور القديمة رغم انشراحها عبر تصنيفاتٍ ازدرائية ميَّزت بين الأناسِ المستعبَدين والمستعبِدين، فهي لم تستلزم بالضرورة استخدامَ أصنافٍ عرقيةٍ مميزة، في حين استخدمتها أنظمة الاستعباد الزراعي-التجاري في كل مكانٍ تقريبًا. وبالتالي لا يمكن افتراضُ تصاحُبٍ ضروريٍّ بين العنصرية والعبودية بحد ذاتيهما. فالاختلافات في الأدوار التي أدتها العبودية في هذه الحُقَب والتشكيلات المختلفة جدًّا هي، على وجه التحديد، ما قد يرشدنا إلى الأرضية الضرورية لتحديد ما قد يؤمنه هذا التصاحب المحدد بين العبودية والعنصرية. وحيث هذا التصاحب يظهر بالفعل، فمن الواجب ألا تُفترضَ مسبقًا آليات اشتغاله وفعاليتها – بما في ذلك تمفصله مع العلاقات الأخرى – دونما تحقيق.
مرةً أخرى، من الواجب تحدّي الافتراض الشائع بأنَّ معتقدات الفوقية العرقية هي ما أدى لنشأة عبودية المزارع التجارية. فقد يكون من الأفضل الابتداء من الجانب الآخر: برؤية كيف أنتجت العبودية (وهي نِتاج مشاكل مميزة: نقص العمالة وتنظيم المزارع، لبّت احتياجاتها بادئًا عمالةٌ غير سوداء مِن السكان الأصليين، ومن ثمَّ عمالةٌ بيضاءُ مُستعبَدة بالديون) الأشكال التشريعية تلك للعنصرية التي امتاز بها عصر عبودية المزارع التجارية. وانشراح الأشكال التشريعية وأشكال الملكية الخاصة للعبودية، كمجموعةِ جيوبٍ وسطَ مجتمعاتٍ مبنية على أشكال قانونية وملْكية أخرى، استلزمَ عملًا أيديولوجيًّا مميزًا ومفصّلًا – ولنا خيرُ شاهدٍ في تاريخ العبودية وتاريخ إلغائها. والنقطة نفسها يمكن تطبيقها، وسحبها، على التفسيرات التي تنسب العنصرية-عمومًا إلى شكلٍ وظيفيٍّ كونيٍّ للسيكولوجيا الفردية – «الحسّ العنصري»، «الغريزة العرقية» – أو يشرح ظهورها بمفردات السيكولوجيا العامة للانحياز. المسألة ليست معنية بما إذا كان عموم الناس يقومون بالتمييز البصري بين المجموعاتِ ذات السمات العرقية أو الإثنية، بل: ما الشروط المميزة التي تجعلُ هذا الشكل من التمييز ذو أهمّيةٍ اجتماعيةٍ وفعالية تاريخية. ما الذي يعطي هذا الإمكان البشري المؤكد فعاليّته، كقوّةٍ ماديةٍ محسوسة؟ يمكن القول، مثلًا، إنّ الهيمنة الإمبريالية الطويلة الأمد لبريطانيا، والعلاقة الوثيقة بين التنمية الرأسمالية في الداخل والغزو الاستعماري في الخارج، وضع أثرًا لعنصريةٍ فاعِلةٍ في الوعي الشعبي البريطاني. ولكن هذا وحده لا يمكن أنْ يفسر الشكل ولا الوظيفة التي اتخذتهما العنصرية، في مرحلة الإمبريالية الشعبية في ذروة التنافس الإمبريالي في خاتمة القرن التاسع عشر، أو الأشكال المختلفة للعنصريات الأهلانية، التي ولجت في عمقِ الطبقة العاملة نفسها، وكانت سمةً ناشئةً للاحتكاك بين العمّال السود والبِيْض في شروط الهجرة ما بعد الحرب العالمية. وتاريخ هذه العنصريات لا يمكن كتابته كـ «تاريخٍ عام».[78] وما يجري من إرجاعها إلى «الطبيعة البشرية» ليست تفاسيرًا، بل ذرائع وأعذار.
على المرء إذن أنْ يبدأ من «العمل» التاريخي المحسوس الذي تنجزه العنصرية تحت شروطٍ تاريخية مميزة – كمجموعةٍ من الممارسات الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية، ذاتِ نوعٍ مميز، متمفصلٍ تمفصلًا محسوسًا مع ممارساتٍ أخرى في تشكيلةٍ اجتماعية. هذه الممارسات تعيّنُ تَمَوقُعَ مجموعاتٍ اجتماعيةٍ مختلفة في علاقاتها ببعضها البعض، بموجب البنى الأولية للمجتمع؛ إنها تثبّت هذه التموقعات وتعيّنها في ممارساتٍ اجتماعية متواصلة، وتشرعن هذه المواقع التي تعينها بموجب ذلك. باختصار، إنها ممارساتٌ تؤمّن هيمنةَ مجموعةٍ مسيطرة على سلسلةٍ من المجموعات التابعة، بنحوٍ يذهب إلى السيطرة على التشكيلة الاجتماعية ككل بشكلٍ موائمٍ للتطوير طويل الأمد للقاعدة الإنتاجية الاقتصادية. ورغم أنّ الأوجه الاقتصادية حيويةٌ، كطريقِ بدءٍ، فهذا الشكل للهيمنة لا يمكن فهمه بصفته مشتغلًا اشتغالًا خالصًا عبر القسر الاقتصادي. والعنصرية، بنشاطها الحيوي على المستوى – «النواة الاقتصادية» – الذي يُصرّ غرامشي على ضرورة تأمينه أولًا، يجب أن تحتك بعلاقاتٍ مفصّلةٍ في لحظات أخرى، في المستويات السياسية والثقافية والأيديولوجية. ولكنْ حتى حينما نصيغها بهذا النحو، فهذا التأكيد ما زالَ قبْليًّا أكثرَ من اللازم. كيف تعمل هذه الآليات على وجه التحديد؟ ما التحديدات الإضافية الواجب توفيرها؟ العنصرية ليست حاضرة، بالشكل نفسه أو الدرجة نفسها، في كل التشكيلات الرأسمالية: إنها ليست ضرورية للاشتغال المحسوس لكل الرأسماليات. يجب تبيان كيف ولماذا أفرطَت تحديدَ العنصريةِ رأسماليّاتٌ معينة عند مراحل مختلفة من تطور هذه الأخيرة، وكيف ولماذا تمفصلت معها. ولا يمكن افتراضُ أنّ على هذا أنْ يتخذ شكلًا واحدًا أحدًا أو يتبع مسلكًا أو منطقًا ضروريًّا واحدًا، عبر سلسلةٍ من المراحل الضرورية.
وهذا، بدوره، يلزمنا بتبيانِ تمفصلها مع البنى المختلفة للتشكيلة الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، موقعُ العبدِ في مجتمع المزارع التجارية قبل التحرير لم يؤمَّن عبر العرق حصرًا. لقد أمّنته بنحوٍ غالبٍ علاقاتُ الإنتاج المميزة والفريدة للغاية للزراعة المستندة إلى العبودية، وعبر فرادةَ حالة الملْكية للعبد (بصفته سلعة) ولقوّة عمل العبد (باتّحادها مع مُمَارسها، الذي لم يكن، رغم ذلك، «مالِكها»)، باقترانٍ مع الأنظمة القانونية والسياسية والأيديولوجية التي أرست هذه العلاقة بالنسب العرقي. لعل هذا الاقتران وفّر منطقًا وإطارًا جاهزيْن لبنى «العنصرية غير الرسمية» تلك التي اشتغلت حينما هاجرت العمالة السوداء «المحررة» شمالًا في الولايات المتحدة، أو إلى نظام «القرى الحرة» في الكاريبي ما-بعد التحرير. ومع ذلك فهذا «الاقتران» اشتغل بطرقٍ جديدة، استلزمت عملها الأيديولوجي الخاص – أي تشريعات «جيم كرو» في ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر.[79] أُمِّنَت إعادة إنتاج الحالة الدونية والموروثة للعمالة السوداء، كجزءٍ مميز من الطبقات «العاملة الحرّة» للرأسمالية الصناعية، بمعونة عنصريةٍ مُغيَّرةٍ بالطبع، ولكنْ من خلال آلياتٍ أخرى أيضًا، أنجزت موضعتها البنيوية بموجب أشكال جديدة لرأس المال بطرقٍ جديدة. في الحالة الأخيرة هذه تطورت صراعاتٌ مرتبطة استغلت الثغرات أو عملت مباشرةً على التناقضات بين النسب العرقي والأيديولوجيات الرسمية لـ «تساوي الفُرص» لم تكن، ببساطة، متوفرة للمستعبَدين السود تحت نظام المزارع التجارية.[80] نحن من سيتضرر من معالجة هذه الاختلافات على أنها «نفس الشيء». ومن جهةٍ أخرى لا يتبع من ذلك أنّ الرأسمالية المتقدمة، لأنها تشتغل هنا غالبًا على أساس «العمالة الحرة»، فالأوجه العرقية للعلاقات الاجتماعية يمكن إدماجها، من كل النواحي العملية، في علاقاتها الطبقية الاعتيادية، كما يفعل كوكس[81] رغم كثرة ملاحظاته المهمة. يستمر العرق بالتفرقة بين الأجزاء المختلفة للطبقات العاملة فيما يتعلق برأس المال، ما يخلق أشكالًا مميزة للتجزئة والتقسيم تحمل أهميةً بسبب طرق تقاطعها مع العلاقات الطبقية (وتقسيمها الصراع الطبقي، داخليًّا) بقدر ما هي مجرد «تعبيرٍ» عن شكلٍ عامٍّ ما للصراع الطبقي. سياسيًّا وثقافيًّا، لهذه العلاقات المركبة واللا-متكافئة بين الطبقة والعرق أهميّةٌ تاريخيةٌ لا تقف عند هذا التصادف فقط. فعلى المستوى الاقتصادي من الواضح أنّ العرق يجب أن يعطى فعاليته الخاصة و«المستقلة نسبيًّا»، كسمةٍ خاصة. وهذا لا يعني أنّ الاقتصاديَّ كافٍ لتأسيس شرحٍ لكيف تعمل هذه العلاقات بنحوها المحسوس. على المرء أن يعرف كيف أدخِلَت المجموعات العرقية والإثنية المختلفة تاريخيًّا، والعلاقات التي مالت إلى حتِّ هذه الاختلافات وتحويلها، أو إلى حفظها مع مرور الزمان – ليس كمحض بقايا أو آثارٍ لأنماطَ قديمة، بل كمبادئ بنائيّةٍ فاعلةٍ للتنظيم الحالي للمجتمع. إنّ الأصناف العرقية وحدها لن توفر هذه أو تشرحها. ما الأشكال والعلاقات المختلفة التي تركَّبت وفقها هذه الأجزاء العرقية تحت رأس المال؟ هل تقف في علاقةٍ مختلفةٍ اختلافًا معتبرًا إزاء رأس المال؟ ما علاقات التذويب/الحفظ بينها؟ كيف عمل العرق لحفظ هذه التمفصلات وتطويرها؟ ما الوظائف التي تنفذها الأنماط المسيطر عليها للإنتاج في إعادة إنتاج النمط المسيطِر؟ هل ترتبط هذه بهِ عبر إعادة الإنتاج المنزلية لقوة العمل «دون قيمتها»، وإمدادات العمالة الرخيصة، وتنظيم «الجيش الاحتياطي للعمل»، وإمدادات المواد الخام، والزراعة الكفافية، والتكاليف الخفية لإعادة الإنتاج الاجتماعي؟ تختلف «الاقتصادات الطبيعية» للمجتمعات الأصلية في أمريكا اللاتينية وأشكال الإنتاج شبه المنزلي الذي تتطبع به المجتمعات الكاريبية اختلافًا معتبرًا، وتختلف فيما بينها أيضًا، في هذا الصدد. والأمر ينطبق أيضًا حتى حيث الأجزاء الإثنية المختلفة تقفُ في المجموعة نفسها من العلاقات برأس المال. فعلى سبيل المثال وضعية العمالة السوداء في الشمال الصناعي الأمريكي والهجرة السوداء إلى بريطانيا ما بعد الحرب تُظهر أنساقَ متمايزةً جدًّا وفق خطوطٍ عرقية، ولكنّ هذه الأحوال لا تقبل الشرح دونَ مفهوم «الجيش الاحتياطي للعمل». ولكن من الواضح أنّ السود ليسوا القسم الوحيد في «الجيش الاحتياطي»، ولذلك فالعرق ليس الآلية الوحيدة التي يُنظَّم بها حجمه وتشكيلته. في الولاياتِ المتحدة توفرَ عنصرٌ بديلٌ معتبرٌ عبر المهاجرين البِيْض (مثل القادمين من أوروبا وأمريكا الوسطى) والنساء، وفي بريطانيا، عبرَ كلٍّ من النساء والإيرلنديين.[82]
بالتالي، إنّ المذهبين المتنافيين الذين مررنا عليهما في الأجزاء الافتتاحية لهذه الورقة، معيقانِ للغاية، على مستوى نظريٍّ، سواءً اختص النقاش بالتشكيلات «الميتروبوليتانية» أو «التابعة»؛ وسيّان إن كان الفحصُ مرتكزًا على أشكالٍ تاريخيةٍ أو معاصرة. مثلما جادلتُ مؤخرًا،[83] إنّ البنى التي يعاد إنتاج العمالة السوداء عبرها، مهما كانت التشكيلة العرقية للعمالة – ليست ببساطة «متلونةً» بالعرق، بل هي تعمل من خلال العرق. يمكن التفكير بعلاقاتِ الرأسمالية بصفتها تُمفصِلُ الطبقاتِ بطرقٍ متمايزة على كلِّ مستوى أو لحظةٍ للتشكيلة الاجتماعية – الاقتصادي، السياسي، الأيديولوجي. هذه المستوياتُ هي «آثار» بُنى الإنتاج الرأسمالي الحديث، مع الإزاحة الضرورية الناجمة عن الاستقلالية النسبية المشتغلة بينها. كلّ مستوى من مستويات التشكيلة الاجتماعية يستلزمُ «وسائل تمثيله» المستقلة – الوسائل التي يظهر بها نمط الإنتاج المبني طبقيًّا ويستحصل فعاليةً على مستوى الصراع الطبقي الاقتصادي السياسي الأيديولوجي. إنّ العرق متأصلٌ في أسلوب تكوينِ الطبقات العاملة السوداء تكوينًا معقّدًا على كلٍّ من هذه المستويات. ويدخل في كيفية توزيع العمالة السوداء، ذكورًا وإناثًا، كفاعلين اقتصاديين عند مستوى الممارسات الطبقية، والصراع الطبقي الناجم عنه؛ وفي كيفية إعادة تكوين أجزاء الطبقات العاملة السوداء، عبر وسائل التمثيل السياسي (الأحزاب، والمنظمات، ومراكز عمل الأحياء، والمنشورات، والحملات) كقوى سياسية في «المسرح السياسي» – والصراعات السياسية الناجمة؛ وكيفية تمفصل الطبقة العاملة بصفتها «الذوات» الجمعية والفردية للأيديولوجيات الناشئة – والصراعات الناجمة حول الأيديولوجيا، والثقافة، والوعي. وهذا يعطي قضية أو بُعدَ العرق، والعنصرية، مركزيةً عمليةً ونظريةً أيضًا في كل العلاقات التي تؤثر بالعمالة السوداء. وتكوينُ هذا الجزء كطبقة، والعلاقات الطبقية التي تَنْسبهُ، تعمل كعلاقاتٍ عرقية. فالعرقُ بالتالي هو الهيئة التي «تُعاشُ» فيها الطبقة، الوسيط الذي من خلاله تُستَشعَر العلاقات الطبقية، شكلُ الاستحواذ على الطبقة وشكل «مكابَدتها». ولهذا الأمر عواقب على كامل الطبقة، وليس فقط قطاعاتها «المعرَّفة عرقيًّا»: له عواقبُ بموجب التقسيم والتجزئة الداخلية ضمن الطبقة التي، من ضمن طرق أخرى، تُمفصَلُ جزئيًّا عبر العرق. وليس هذا الأمر مجرد مؤامرةٍ عنصريةٍ من الأعلى. فالعنصرية هي إحدى الوسائل المسيطرة للتمثيل الأيديولوجي، أيضًا، التي من خلالها «تعيش» الأجزاء البيضاء من الطبقة علاقاتها بالأجزاء الأخرى، وإزاء رأس المال نفسه. إنّ الساعين، سعيًا مؤثرًا، لفكّ تمفصل بعض التراكيب الموجودة للصراع الطبقي (إنما بنوعٍ فئويٍّ أو إصلاحي-اجتماعي) وإعادة مفصلة التجربة الطبقية من خلال نداءاتٍ مكثّفة ذات تركيبٍ أيديولوجيٍّ عنصريٍّ، هؤلاء بالطبع وُكلاء مفتاحيّون لعمل التحويل الأيديولوجي هذا. هذا هو الصراع الطبقي الأيديولوجي، الذي يُسعى وراءه تحديدًا من خلال تسخير الطبقات المُسيطَر عليها لصالح رأس المال عبر مفصلةِ التناقضات الداخلية للتجربة الطبقيةِ مع العنصرية. في بريطانيا حصلت هذه العملية مؤخرًا على صيتٍ نادرٍ وعامٍّ. ولكنهم ينجحون بهذا القدر فقط لتمرّسهم بتناقضات حقيقية بين الطبقة وداخلها، عاملين على آثار حقيقية للبنية (مهما «سيء إدراكها» عبر العنصرية) – ليس لأنّهم ليسوا نبيهين في طرد شياطينهم، أو لأنهم يلوّحون بالصليب المعقوف، أو يقرؤون «كفاحي». العنصرية، إذن، ليست مشكلةً خاصة بالسود الملزمين بمكابدتها. وليست حتى مشكلةً خاصة فقط بتلك الأجزاء من الطبقة العاملة البيضاء وتلك التنظيمات الملطخة بقذارتها. ولا يمكن التغلب عليها، كفيروسٍ عامٍّ في الجسد الاجتماعي، بجرعةٍ قويّةٍ من التحصين الليبرالي. رأس المال يعيد إنتاج العلاقات الطبقية، بما في ذلك تناقضاتها الداخلية، بمجملها، مبنيّةً بالعرق. إنه يسيطر على الطبقة المقسَّمة، جزئيًّا، عبر تلك الانقسامات الداخلية التي تحملُ العنصرية كأحد آثارها. وهو يحتوي مؤسسات التمثيل الطبقي ويعقيها، عبر تحييدها، حاصرًا إياها باستراتيجياتٍ ونضالاتٍ مخصصةٍ عرقيّة، لا ترقى فوق حدوده، فوق حاجزه. من خلال العنصرية يقدر على هزيمة محاولاتِ بناءِ وسائلَ بديلة للتمثيل، أكثرُ مواءمةً لتمثل الطبقة ككل، أو قادرةٌ على تفعيل وحدة الطبقة كنتيجة، أي: تلك البدائل التي ستمثّل الطبقة ككل بنحوٍ لائق – ضدّ الرأسمالية، ضدّ العنصرية. تستمر الصراعات الجزئية، المتمفصلة بالعرق والمنشرحة عبره، بدلًا من ذلك، بالظهور كالاستراتيجيات الدفاعية الضرورية لطبقةٍ منقسمةٍ ضدّ نفسها، وجهًا لوجه مع رأس المال. ولهذا هي أيضًا، بالتالي، مواقعُ الهيمنة المستمرة لرأس المال عليها. وهذا بالتأكيد لا يعني معالجة العنصرية، بأي معنى بسيطٍ، كمنتوج خدعةٍ أيديولوجية.
ومع ذلك، هكذا تحليل بحاجة لتكميله بتحليلٍ للأشكال المميزة التي تتخذها العنصرية في عملها الأيديولوجي. هنا من اللازم علينا الابتداء بالطرق المختلفة التي بنيت بها الأيديولوجيات العنصرية وأدخلت حيز العمل تحت شروطٍ تاريخيةٍ مختلفة: عنصريات النظرية المركنتالية وعنصريات العبودية؛ عنصريات الغزو والاستعمار؛ عنصريات التجارة و«الإمبريالية العالية»؛ الإمبريالية الشعبية و«ما بعد الإمبريالية» الدعيّة. في كل حالةٍ، في كل تشكيلةٍ اجتماعية مميزة، تكفلت العلاقاتُ الطبقية المسيطِرة بإعادة تشكيل العنصرية، بصفتها إعدادًا أيديولوجيًّا، وأعادت صياغتها بنحوٍ شامل. فإن كانت قد أدت وظيفةَ أيديولوجيةِ التدعيم التي تؤمّن تشكيلةً اجتماعيةً كاملة تحت طبقةٍ مسيطرةٍ، فاختلافاتها المهمة عن غيرها من الأيديولوجيات المهيمنة تستلزم التسجيل بالتفاصيل. هنا، للعنصرية قوّة شديدةٌ ولطبعتها على الوعي الشعبي عمقٌ خاص، لأنّه في سماتٍ عرقية مثل اللون، الأصل الإثني، الموضع الجغرافي، إلخ، تَكْتَشفُ العنصرية ما على الأيديولوجيات الأخرى بناؤه: أساسٌ «طبيعي» وكونيٌّ ظاهريًّا في الطبيعةِ نفسها. ولكن، رغم هذا التأسيس الظاهريّ في معطياتٍ بيولوجية، خارج التاريخ، للعنصرية حينما تظهر أثرٌ على التشكيلات الأيديولوجية الأخرى داخل المجتمع نفسه، وتطوّرها يروج لتحويل كامل الحقل الأيديولوجي الذي تشتغل فيه. فبإمكانها، بهذا النحو، تسخير الخطاباتِ الأيديولوجية الأخرى لنفسها (مثلًا: إنها تتمفصل بإحكامٍ مع بُنية «نحن/هم» للوعي الطبقي الفئوي) عبر الآليّاتٍ التي ناقشناها أعلاه للتكثيف المضاميني. وآثارها مشابهةٌ للأيديولوجيات الأخرى التي، على أرضياتٍ أخرى، يجب تمييزها عنها: العنصريّات تلغي التاريخية – تترجمُ بنىً مميزةٍ تاريخيًّا إلى اللغة السرمدية للطبيعة؛ فتفكّك الطبقاتِ إلى أفرادٍ وتعيد تركيبهم كأفرادٍ مجزّئين في الوحدات المعاد تأسيسها، المُتماسِكاتِ الكبرى، لـ «الذوات» الأيديولوجية الجديدة: إنها تترجم «الطبقات» إلى «سود» و«بِيْض»، والمجموعات الاقتصادية إلى «شعوب»، والقوى الفعلية إلى «أعراق». هذه العملية هي عملية تكوين «ذوات تاريخية» جديدة للخطابات الأيديولوجية – الآلية التي واجهناها مسبقًا، لتشكيل بنىً ندائيةٍ جديدة. إنها تنتجهم، بصفتهم «المؤلِّفين» الطبيعيين والمعطَيين لأشكال عفوية للإدراك العرقي، كـ «الذات العنصرية» المُطبْعَنة. وهذه ليست وظيفةً خارجية، تعمل فقط ضدّ أولئك الذين تتصرف بهم أو تفكّ تمفصلهم (تُصْمِتهم). من المهم أيضًا للذوات المُسيطَر عليها – تلك المجموعات الإثنية أو «الأعراق» المُخْضَعة التي تعيش علاقتها بالشروط الحقيقية لوجودها، أو بسيطرة الطبقات المسيطِرة، في ومن خلال التمثيلات التخيلية لمناداةٍ عنصرية، ويبدؤون يستشعرونَ أنفسهم كـ «الدونيين»، الآخرون (les autres). ومع ذلك فهذه العمليات هي نفسها لا تُعفى أبدًا من الصراع الطبقي الأيديولوجي. فللنداءات العرقية أن تصبح هي نفسها مواقع ومُرتَهناتٍ في الصراع الطبقي، تُحتل ويعاد تعريفها لتغدو أشكالَ بدائيةً لتشكيلٍ معارِض – مثل أن يتنازع على «العنصرية البيضاء» بحيوية من خلال عمليّاتِ القلبِ الرمزية لـ «القوة السوداء». وأيديولوجيات العنصرية تظلُّ بنى تناقضية، لها أنْ تعمل كمركباتٍ لفرض الأيديولوجيات المسيطِرة، وكأشكال بنائية لثقافاتِ المقاومَة. وأيُّ محاولة لرسم حدود سياسة العنصرية وأيديولوجياتها، تغفلُ هذه السمات المستمرة للصراع والتناقض، فلياقتها الظاهرية للتفسير لا تحوز عليها إلّا بتفعيل اختزاليّةٍ مُعيقَة.
في حقل البحث هذا، ما زال على «النظرية السوسيولوجية» إيجاد طريقها، عبر الجهد الصعب للتوضيح النظري، عبر «سيلا» اختزاليةٍ يجب أن تنفي كل شيءٍ تقريبًا لتشرح شيئًا ما، و«كاريبد»4سيلا وكاريبد: في الأساطير اليونانية، كانت سيلا وحشًا يحدّ مضيقًا ضيقًا في طرفه الآخر دوامة كاريبد، فإنْ ابتعدت السفن عن إحداهما اقتربت للأخرى، ويشير المثل هنا إلى الاختيار بين أمرين أحلاهما مر. تعدديٍّ مفتونٌ بـ «كل شيء» حتى بات عاجزًا عن شرح أي شيء. لأولئك المستعدين لمواصلة العمل، ما زالت المهنة شاغرة.
الحواشي
[1] Wolpe, Harold. 1976. “The White Working Class in South Africa.” Economy and Society 5, no. 2.
[2] Kuper, Leo. 1974. Race, Class and Power. London: Duckworth.
[3] van den Berghe, P. L. 1965. South Africa: A Study in Conflict. Middletown, CT: Wesleyan University Press.
[4] Rex, John. 1973. Race, Colonialism and the City. London: Routledge and Kegan Paul.
[5] Smith, M. G. 1965. The Plural Society in the British West Indies. Berkeley: University of California Press.
[6] Rex, Race, Colonialism and the City, 261.
[7] Ibid, 262.
[8] Rex, Race, Colonialism and the City, 278.
[9] Marx, Karl. 1973. “1857 Introduction to The Grundrisse.” London: Penguin, 58.
[10] Rex, John. 1977. “New Nations and Ethnic Minorities.” In unesco, Race and Class in Post-Colonial Society: A Study of Ethnic Group Relations in the English-Speaking Caribbean, Bolivia, Chile and Mexico. Paris: unesco.
[11] Ibid, 30.
[12] Marx, Karl. 1961. Capital, vol. 1. Moscow: Foreign Languages Publishing House. 170.
أنظر:
McLennan, Gregor. 1976. Some Problems in British Marxist Historiography. Birmingham, UK: Centre for Contemporary Cultural Studies.
و
Schwarz, Bill. 1978. “On Maurice Dobb.” In Richard Johnson, Gregor McLennan, and Bill Schwarz, Economy, History, Concept, Centre for Contemporary Cultural Studies, Occasional Paper 50.
[14] Rex, Race, Colonialism and the City, 273.
[15] Rex, “New Nations and Ethnic Minorities,” 23-24, 45.
[16] Wolpe, “The White Working Class in South Africa.”
[17] Wolpe, Harold. 1975. “The Theory of Internal Colonialism.” In Beyond the Sociology of Development: Economy and Society in Latin America and Africa, edited by Ivar Oxall, Tony Barnett, and David Booth. London: Routledge and Kegan Paul. 203.
[18] Carchedi, Guglielmo. 1977. On the Economic Identification of Social Classes. London: Routledge and Kegan Paul.
[19] Marx, Karl. 1964. Precapitalist Economic Formations. Edited by Eric Hobsbawm. London: Lawrence and Wishart.
[20] Genovese, Eugene. 1965. The Political Economy of Slavery: Studies in the Economy and Society of the Slave South. New York: Vintage; Hindess, Barry, and Paul Hirst. 1975. Pre-capitalist Modes of Production. London:Routledge and Kegan Paul.
[21] Furtado 1971.
مستشهد به في:
O’Brien, P. 1975. “A Critique of Latin American Theories of Dependency.” In Beyond the Sociology of Development: Economy and Society in Latin America and Africa, edited by Ivar Oxall, Tony Barnett, and David Booth. London: Routledge and Kegan.
[22] O’Brien, “A Critique of Latin American Theories of Dependency.”
[23] Frank, Andre Gunder. 1969. Capitalism and Underdevelopment in Latin America. New York: Monthly Review Books.
[24] Ibid.
[25] Laclau, Ernesto. 1977. Politics and Ideology in Marxist Theory. London: New Left Books.
[26] Marx, Karl. 1974. Capital. Vol. 3. London: Lawrence and Wishart. 319-321
[27] Genovese, Eugene. 1971. In Red and Black: Marxian Explorations in Southern and Afro-American History. Knoxville: University of Tennessee Press.
[28] Williams, Eric. 1944. Capitalism and Slavery. Chapel Hill: University of North Carolina Press; Genovese, In Red and Black; Hindess, Barry, and Paul Hirst. 1977. Modes of Production and Social Formation. London: Routledge and Kegan Paul; Banaji, Jairus. 1977. “Modes of Production in a Materialist Conception of History.” Capital and Class 3; Fogel, Robert, and Stanley Engerman. 1974. Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery. Boston: Little, Brown and Company.
[29] Beechey, Veronica. 1978. “The Ideology of Racism.” DPhil diss., Oxford University.
[30] Marx, Capital, vol. 3, 773
[31] Beechey, “The Ideology of Racism.”
[32] Althusser, Louis, and Étienne Balibar. 1970. Reading Capital. London: New Left Books; Hindess and Hirst, Pre-capitalist Modes of Production; Hindess, Barry, and Paul Hirst. 1977. Modes of Production and Social Formation. London: Routledge and Kegan Paul; Poulantzas, Nicos. 1973. Political Power and Social Classes. London: New Left Books.
[33] Marx, Karl. 1956. Capital, vol. 2. London: Lawrence and Wishart. 109.
[34] Bettelheim, Charles. 1972. “Theoretical Comments.” In Unequal Exchange: A Study of the Imperialism of Trade, by Arghiri Emmanuel, 271–322. New York: Monthly Review Books.
[35] Wolpe, “The Theory of Internal Colonialism.”
[36] Wolpe, Harold. 1972. “Capitalism and Cheap Labour in South Africa.” Economy and Society 1, no. 4.
[37] Wolpe, “The Theory of Internal Colonialism.”
[38] Marx, Capital, vol. 3, 918.
[39] لشرحٍ أوسعٍ لهذه “المقدمات الأساسية” لطريقة ماركس، أنظر:
Johnson, Richard, Gregor McLennan, and Bill Schwarz. 1978. Three Approaches to Marxist History. Centre for ContemporaryCultural Studies, Occasional Paper 50.
و
Johnson, Richard. 1978. Unpublished mimeographed papers, Centre for Contemporary Cultural Studies.
ولنسخةٍ موجزة للحجة التي وضعها وولب، بتطبيقها على التشكيلات الاجتماعية لأمريكا اللاتينية والكاريبي، أنظر:
Hall, Stuart. 1977. “Pluralism, Race and Class in Caribbean Society.” In Race and Class in Post- colonial Society: A Study of Ethnic Group Relations in the English- Speaking Caribbean, Bolivia, Chile and Mexico. Paris: unesco.
[40] Hindess and Hirst Pre-capitalist Modes of Production; Hindess and Hirst. Modes of Production and Social Formation.
[41] Banaji, “Modes of Production.”
[42] مثل:
Alavi, Hamza. 1975. “India and the Colonial Mode of Production.” Socialist Register.
[43] Hilton, Rodney, ed. 1976. The Transition from Feudalism to Capitalism. London: New Left Books
[44] Post, Ken. 1978. Arise, Ye Starvelings: The Jamaican Labour Rebellion of 1938 and Its Aftermath. New York: Springer.
[45] أنظر المختارات في:
Seddon, J. D., ed. 1978. “Introduction.” In Relations of Production. London: Cass.
ولأجل نظرة عامة وانتقادات بالإنجليزية، أنظر:
Clammer, John. 1975. “Economic Anthropology and the Sociology of Development.” In Beyond the Sociology of Development: Economy and Society in Latin America and Africa, edited by Ivar Oxall, Tony Barnett, and David Booth, 208–28. London: Routledge and Kegan Paul; Bradby, Barbara. 1975. “The Destruction of the Natural Economy.” Economy and Society 4, no. 2: 127–61; Foster-Carter, Aidan. 1978. “The Modes of Production Controversy.” New Left Review, no. 107: 47–77; Seddon, “Introduction”; Wolpe, Harold. 1978. “The Articulation of Modes of Production.” Unpublished ms.
من بين آخرين.
[46] Meillassoux, Claude. 1972. “From Production to Reproduction.” Economy and Society 1, no. 1; Meillassoux, Claude. 1974. Imperialism as a Mode of Reproduction of Labour Power.Unpublished mimeograph.
ولنقد أوسع:
Clammer, “Economic Anthropology and the Sociology of Development.”
[47] Rey, Pierre-Philippe. 1971. Colonialisme, neo-colonialisme, et transition au capitalisme. Paris: Maspero; Rey, Pierre-Philippe. 1973. Les alliances de classes. Paris: Maspero; Rey, Pierre-Philippe. 1975. “Power, Descent and Reproduction: Reflections on the ‘Lineage Mode of Production’ in Chinese Society.” Critique of Anthropology 3; Rey, Pierre-Philippe, and Georges Dupré. 1973. “Reflections on the Pertinence of a Theory of Exchange.” Economy and Society 2, no. 2.
[48] Foster-Carter, “The Modes of Production Controversy.”
[49] Foster-Carter, “The Modes of Production Controversy.”
[50] ولنقدٍ أوسع، أنظر:
Cutler, Antony, et al. 1977. Marx’s “Capital” and Capitalism Today. Vol. 1. London: Routledge and Kegan Paul; Foster-Carter, “The Modes of Production Controversy”; Terray, Emmanuel. 1972. Marxism and “Primitive” Societies. New York: Monthly Review; Bradby, “The Destruction of the Natural Economy.”
[51] Althusser, Louis. 1965. For Marx. London: Allen Lane.
[52] Althusser and Balibar.
[53] Lenin, V. I. 1932. Letters from Afar. New York: International Publishers.
[54] Althusser and Balibar, 47.
[55] Ibid, 204.
[56] Ibid, 207.
[57] Ibid, 220
[58] Hindess and Hirst, Pre-capitalist Modes of Production.
[59] Barthes, Roland. 1967. Elements of Semiology. London: Cape Editions.
[60] Marx, “1857 Introduction.”
[61] أنظر:
Hall, Stuart. 1974. “Marx’s Notes on Method: A ‘Reading’ of the 1857 Introduction to the Grundrisse.” Working Papers in Cultural Studies 6. Birmingham: Centre for Contemporary Cultural Studies, University of Birmingham.
[62] Marx, “1857 Introduction.”
[63] Foster-Carter, “The Modes of Production Controversy.”
[64] Marx, “1857 Introduction,” 70.
[65] Althusser, Louis. 1976. Essays in Self-Criticism. London: New Left Books.
[66] Hindess and Hirst. Pre-capitalist Modes of Production, 385–412.
[67] Hirst, Paul. 1976. “Althusser’s Theory of Ideology.” Economy and Society 5, no. 4; Cutler, Marx’s “Capital”.
[68] Hall, Stuart, Bob Lumley, and Gregor McLennan. 1977. “Politics and Ideology: Gramsci.” Working Papers in Cultural Studies 10.
[69] لأجل المطالعة، أنظر:
Hall et al, “Politics and Ideology: Gramsci”; Anderson, Perry. 1977. “The Antinomies of Antonio Gramsci.” New Left Review 100; Mouffe, Chantal. 1978. Unpublished paper on Gramsci.
[70] كافة هذه الاقتباسات من مقالين في:
Gramsci, Antonio. 1971. Selections from the Prison Notebooks. Edited by Geoffrey Nowell Smith and Quintin Hoare. London: Lawrence and Wishart.
[71] Althusser, Louis. 1971. Lenin and Philosophy and Other Essays. London: New Left Books.
[72] Laclau, Politics and Ideology.
[73] Poulantzas, Political Power and Social Classes.
[74] O’Shea, Alan. 1978. “A Critique of Laclau’s Theory of Interpellation.” Birmingham, UK: Centre for Contemporary Cultural Studies. Mimeograph.
[75] Mouffe.
[76] Marx, “1857 Introduction.”
[77] Finley, Moses. 1969. “The Idea of Slavery.” In Slavery in the New World, edited by Eugene Genovese and Laura Foner. Englewood Clifs, NJ: Prentice Hall; Davis, David Brion. 1966. The Problem of Slavery in Western Culture. Ithaca, NY: Cornell University Press; Davis, David Brion. 1969. “The Comparative Approach to American History: Slavery.” In Slavery in the New World, edited by Eugene Genovese and Laura Foner. Englewood Clifs, NJ: Prentice Hall.
[78] Hall, “Pluralism, Race and Class”; Hall, Stuart, Charles Critcher, Tony Jefferson, John Clarke, and Brian Roberts. 1978. Policing the Crisis: “Mugging,” the State and Law and Order. London: Macmillan.
[79] Woodward, C. Vann. 1957. The Strange Career of Jim Crow. New York: Oxford University Press.
[80] Myrdal, Gunnar. 1962. An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy.New York: Harper and Row.
[81] Cox, Oliver. 1970. Caste, Class and Race: A Study in Social Dynamics. New York: Monthly Review Books.
[82] أنظر:
Braverman, Harry. 1975. Labor and Monopoly Capital. New York: Monthly Review Books; Castles, Stephen, and Godula Kosack. 1973. Immigrant Workers and Class Structure in Western Europe. London: Oxford University Press.
[83] Hall, “Pluralism, Race and Class in Caribbean Society.
المراجع
Alavi, Hamza. 1975. “India and the Colonial Mode of Production.” Socialist Register 12.
Althusser, Louis. 1969. For Marx. London: Allen Lane.
Althusser, Louis. 1971. Lenin and Philosophy and Other Essays. London: New Left Books.
Althusser, Louis. 1976. Essays in Self- Criticism. London: New Left Books.
Althusser, Louis, and Étienne Balibar. 1970. Reading Capital. London: New Left Books.
Anderson, Perry. 1976. “The Antinomies of Antonio Gramsci.” New Left Review, no. 100.
Banaji, Jarius. 1977. “Modes of Production in a Materialist Conception of History.” Capital and Class 1, no. 3 (October): 1–44.
Barthes, Roland. 1967. Elements of Semiology. London: Cape Editions.
Beechey, Veronica. 1978. “The Ideology of Racism.” DPhil diss., Oxford University.
Bettelheim, Charles. 1972. “Theoretical Comments.” In Unequal Exchange: A Study of the Imperialism of Trade, by Arghiri Emmanuel, 271–322. New York: Monthly Review Books.
Bradby, Barbara. 1975. “The Destruction of the Natural Economy.” Economy and Society 4, no. 2: 127–61.
Braverman, Harry. 1975. Labor and Monopoly Capital. New York: Monthly Review Books.
Carchedi, Guglielmo. 1977. On the Economic Identification of Social Classes. London: Routledge and Kegan Paul.
Castles, Stephen, and Godula Kosack. 1973. Immigrant Workers and Class Structure in Western Europe. London: Oxford University Press.
Clammer, John. 1975. “Economic Anthropology and the Sociology of Development.” In Beyond the Sociology of Development: Economy and Society in Latin America and Africa, edited by Ivar Oxall, Tony Barnett, and David Booth, 208–28. London: Routledge and Kegan Paul.
Cox, Oliver. 1970. Caste, Class and Race: A Study in Social Dynamics. New York: Monthly Review Books.
Cutler, Antony, et al. 1977. Marx’s “Capital” and Capitalism Today. Vol. 1. London: Routledge and Kegan Paul.
Davis, David Brion. 1966. The Problem of Slavery in Western Culture. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Davis, David Brion. 1969. “The Comparative Approach to American History: Slavery.” In Slavery in the New World, edited by Eugene Genovese and Laura Foner. Englewood Clifs, NJ: Prentice Hall.
Finley, Moses. 1969. “The Idea of Slavery.” In Slavery in the New World, edited by Eugene Genovese and Laura Foner. Englewood Clifs, NJ: Prentice Hall.
Fogel, Robert, and Stanley Engerman. 1974. Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery. Boston: Little, Brown and Company.
Foster-Carter, Aidan. 1978. “The Modes of Production Controversy.” New Left Review, no. 107: 47–77.
Frank, Andre Gunder. 1969. Capitalism and Underdevelopment in Latin America. New York: Monthly Review Books.
Genovese, Eugene. 1965. The Political Economy of Slavery: Studies in the Economy and Society of the Slave South. New York: Vintage.
Genovese, Eugene. 1969. The World the Slaveholders Made: Two Essays in Interpretation. New York: Pantheon.
Genovese, Eugene. 1971. In Red and Black: Marxian Explorations in Southern and Afro-American History. Knoxville: University of Tennessee Press.
Gramsci, Antonio. 1971. Selections from the Prison Notebooks. Edited by Geoffrey Nowell Smith and Quintin Hoare. London: Lawrence and Wishart.
Hall, Stuart. 1974. “Marx’s Notes on Method: A ‘Reading’ of the 1857 Introduction to the Grundrisse.” Working Papers in Cultural Studies 6. Birmingham: Centre for Contemporary Cultural Studies, University of Birmingham.
Hall, Stuart. 1977. “Pluralism, Race and Class in Caribbean Society.” In Race and Class in Post- colonial Society: A Study of Ethnic Group Relations in the English- Speaking Caribbean, Bolivia, Chile and Mexico. Paris: unesco.
Hall, Stuart, Charles Critcher, Tony Jefferson, John Clarke, and Brian Roberts. 1978. Policing the Crisis: “Mugging,” the State and Law and Order. London: Macmillan.
Hall, Stuart, Bob Lumley, and Gregor McLennan. 1977. “Politics and Ideology: Gramsci.” Working Papers in Cultural Studies 10.
Hilton, Rodney, ed. 1976. The Transition from Feudalism to Capitalism. London: New Left Books.
Hindess, Barry, and Paul Hirst. 1975. Pre-capitalist Modes of Production. London: Routledge and Kegan Paul.
Hindess, Barry, and Paul Hirst. 1977. Modes of Production and Social Formation: An Autocritique of “Pre- capitalist Modes of Production”. London: Macmillan.
Hirst, Paul. 1976. “Althusser and the Theory of Ideology.” Economy and Society 5, no. 4: 385–412.
Johnson, Richard. 1978. Unpublished mimeographed papers, Centre for Contemporary Cultural Studies, University of Birmingham.
Johnson, Richard, Gregor McLennan, and Bill Schwarz. 1978. “Three Approaches to Marxist History.” Occasional Paper 50. Centre for Con temporary Cultural Studies, University of Birmingham.
Kuper, Leo. 1974. Race, Class and Power. London: Duckworth.
Laclau, Ernesto. 1977. Politics and Ideology in Marxist Theory. London: New Left Books.
Lenin, V. I. 1932. Letters from Afar. New York: International Publishers.
Marx, Karl. 1956. Capital. Vol. 2. London: Lawrence and Wishart.
Marx, Karl. 1961. Capital. Vol. 1. Moscow: Foreign Languages Publishing House.
Marx, Karl. 1964. Precapitalist Economic Formations. Edited by Eric Hobsbawm. London: Lawrence and Wishart.
Marx, Karl. 1973. “1857 Introduction to the Grundrisse.” London: Penguin.
Marx, Karl. 1974. Capital. Vol. 3. London: Lawrence and Wishart.
Marx, Karl, and Friedrich Engels. 1967. The Communist Manifesto. New York: Penguin Books.
McLennan, Gregor. 1976. “Some Problems in British Marxist Historiography.” Centre for Contemporary Cultural Studies, University of Birmingham.
Meillassoux, Claude. 1960. “Essai d’interpretation du phénomène economique dans les sociétés traditionnelles d’autosubsistence.” Cahiers d’études africaines 4.
Meillassoux, Claude. 1972. “From Production to Reproduction.” Economy and Society 1, no. 1: 93–105.
Meillassoux, Claude. 1974. “Imperialism as a Mode of Reproduction of Labour Power.” Unpublished seminar paper.
Moufe, Chantal. 1979. “Introduction: Gramsci Today.” In Gramsci and Marxist Theory, edited by Chantal Moufe, 1–18. London: Routledge and Kegan Paul.
Myrdal, Gunnar. 1962. An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy. New York: Harper and Row.
O’Brien, Philip J. 1975. “A Critique of Latin American Dependency Theories.” In Beyond the Sociology of Development: Economy and Society in Latin America and Africa, edited by Ivar Oxall, Tony Barnett, and David Booth, 7–27. London: Routledge and Kegan Paul.
O’Shea, Alan. 1978. “A Critique of Laclau’s Theory of Interpellation.” Mimeograph. Centre for Con temporary Cultural Studies, University of Birmingham.
Post, Ken. 1978. Arise, Ye Starvelings: The Jamaican Labour Rebellion of 1938 and Its Aftermath. New York: Springer.
Poulantzas, Nicos. 1973. Political Power and Social Classes. London: New Left Books.
Rex, John. 1970. Race Relations in Sociological Theory. London: Weidenfeld and Nicolson.
Rex, John. 1973. Race, Colonialism and the City. London: Routledge and Kegan Paul.
Rex, John. 1977. “New Nations and Ethnic Minorities.” In Race and Class in Postcolonial Society: A Study of Ethnic Group Relations in the English- Speaking Caribbean, Bolivia, Chile and Mexico. Paris: unesco.
Rey, Pierre-Philippe. 1971. Colonialisme, neo-colonialisme, et transition au capitalisme. Paris: Maspero.
Rey, Pierre-Philippe. 1973. Les alliances de classes. Paris: Maspero.
Rey, Pierre-Philippe. 1975. “Power, Descent and Reproduction: Reflections on the ‘Lineage Mode of Production’ in Chinese Society.” Critique of Anthropology 3.
Rey, Pierre-Philippe, and Georges Dupré. 1973. “Reflections on the Pertinence of a Theory of Exchange.” Economy and Society 2, no. 2.
Rose, Stephen, John Hambley, and Jef Haywood. 1973. “Science, Racism and Ideology.” Socialist Register 10.
Schwarz, Bill. 1978. “On Maurice Dobb.” In Economy, History, Concept, by Richard Johnson, Gregor McLennan, and Bill Schwarz. Centre for Contemporary Cultural Studies, University of Birmingham, Occasional Paper 50.
Seddon, J. D., ed. 1978. “Introduction.” Relations of Production. London: Cass.
Smith, M. G. 1965. The Plural Society in the British West Indies. Berkeley: University of California Press.
Terray, Emmanuel. 1972. Marxism and “Primitive Societies”. New York: Monthly Review Books.
van den Berghe, P. L. 1965. South Africa: A Study in Conflict. Middletown, CT: Wesleyan University Press.
Williams, Eric. 1944. Capitalism and Slavery. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Wolpe, Harold. 1972. “Capitalism and Cheap Labour in South Africa.” Economy and Society 1, no. 4: 425–56.
Wolpe, Harold. 1975. “The Theory of Internal Colonialism.” In Beyond the Sociology of Development: Economy and Society in Latin America and Africa, edited by Ivar Oxall, Tony Barnett, and David Booth, 229–52. London: Routledge and Kegan Paul.
Wolpe, Harold. 1976. “The White Working Class in South Africa.” Economy and Society 5, no. 2: 197–240.
Wolpe, Harold, ed. 1980. The Articulation of Modes of Production: Essays from Economy and Society. London: Routledge and Kegan Paul.
Woodward, C. Vann. 1957. The Strange Career of Jim Crow. New York: Oxford University Press
نشر هذا المقال أولًا لصالح منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، وحاولت جمعية الهامش للأبحاث الاجتماعية الحصول على رخصة لترجمته ولم تتلقى ردًّا حتى الآن.
هذا المقال جزء من منشور «جدل تاريخي: الدولة وعناصرها».